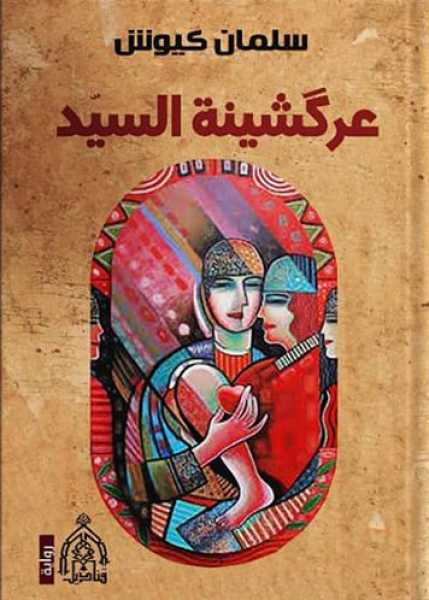إبراهيم
الأعاجيبي
من الرواياتِ التي يجب أن تتحول إلى عملٍ سينمائي يُترجم إلى
لغاتٍ مختلفة، إنها تُجسد الجنوب العراقي بملوحتهِ، كان الكاتبُ
عالماً عارفاً بلغةِ وطبيعةِ الجنوبيين، تبدأ الرواية بحدثٍ
ذو دلالة عميقة أتقن صناعته الكاتب، يبدأه بعمليةِ تغيير اسم
الطالب المقبل على دراسة الماجستير في علم النفس، يدقق موظف التدقيق
في معلوماته الشخصية فيجد أن اسم والدة الطالب خوشية، يسأله عن اسم
أمهِ الصحيح فيجيبه أنها حوشية وليست خوشية ولاتوجد امرأة بهذا
الاسم، يرفض المدقق المعاملة وهنا تبدأ الرواية من هذا الحدث، فالإسم
على ما يبدو جنوبي ومن العمارة، على الطالب أن يذهب إلى دائرةِ
نفوس العمارة ليُغيّر اسم والدته، يمضي الطالب البغدادي إلى
العمارة وهناك يتم التعارف بينه وبين السيد هاني الناجي، يرى
السيد الناجي حيرة هذا البغدادي في دائرة نفوس العمارة، يأخذه
السيد إلى بيته ليحل له مشكلته، إن السيد يأخذ سلمان إلى البيت دون
أن يعرف مشكلته أو اسمه ونسبه، هذه ميزة تضاف إلى الجنوبيين أنهم
كرماء، يطرق الباب فيوعز إلى زوجته: علوية وياي خطار من بغداد
فترد العلوية : يا هلا بالخطار.
يقوم بضيافتهِ أحسن ضيافة وذلك قمة الإيثار أن يقوم بمحاولة ذبح
الديك الوحيد، ألحَّ سلمان بأنه جائعٌ ويريد أن يأكل الموجود
وألا يذبح الديك، يأكل صحن بيض وسيّاح التي تجيده العلوية، يقص
سلمان على السيد مشكلتهِ، يخبره أن الحل بسيط جداً وعليه ألا
يكترث، يأخذه إلى سوق العمارة في الماجديةِ، سلمان ينذهل من
السيد الناجي الشخصية الجنوبية المحترمة بين أبناء مدينتهِ، يمضي
السيد و ضيفه ويمران على الجسر، يرى سلمان اختناق السيد وحسرته بهذا
المكان، لعل ذروة القصة بدأت من هنا، ليكتشف سلمان بعدها أن السيد
عاشقٌ، وقصة عشقه غريبة الأطوار، السيد متزوج ولديه طفله أسمها
خديجة وهذه البنت مريضة بمرضٍ من الأمراض الخبيثة، سلمان يسأل
السيد عن هذه العلاقة الغريبة الأطوار والغير مألوفة، كيف اقترب الحب
إلى قلبِ السيد بمثلِ ظروفه! يبدأ السيد بسرد قصة عشقه بالرمز،
بعد أن يحل مشكلته وذلك بخلط مسحوق القاصر والليمون ويأخذ من
المخلوط بحجم عود الثقاب، يمسح النقطة التي على أسم حوشية، وغداً
يختم على الاسم وبذلك تنتهي مشكلة سلمان، يوصله إلى كراج ويدفع
كروته دون أن يشعر رغم التصاقه به لكن السيد استغل الثواني
المعدودات ليدفع أجرة الأستاذ البغدادي، يتصل السيد بسلمان على حين
فجأة، لأنه ذهب لواجب العزاء في بغداد، سلمان كان متشوقاً لمعرفة
قصة عشق السيد، كانت حبيبة السيد طالب في معهد المعلمين ووصفت بأنها
المعلمة الواعدة، الجسر كان هو المكان الذي يتبادل العاشقان
مشاعرهما بحرصٍ بالغٍ، كان لديهما سجلاً، يوم عنده ويوم عندها
ليكتبا به مشاعرهما، ذات يوم لا بد ان يُفتضح أمرهما، بالفعل
يأتي ذات يوم، بينما هما يتبادلان أعذب كلمات الهوى ويشتكيان
تباريح الهوى، تقبل عليهما سيارة لاندكَروز ، يأخذوا ابنتهم سحلاً،
وينهالوا على السيد بالضرب المبرح، يأخذ أحدهم السكين ويجرحه بصدرة
جرحاً عميقاً، يتركونه ويمضون ويبقى السيد يعاني الألم والجرح،
يبقى يحبها ولم ينقطع عن الجسر، ذات يوم تخبره برسالةٍ مع
أحدى المتعلمات أنها قد تزوجت ابن عمها وهي سعيدة جداً معه وأنها
تسكن في قرى أم كَعيدة وأعطته رمز بأن الماء يحيط بها، حاول السيد
أن يذهب ويجوب قرى أم كعيدة كلها حتى يعثر عليها، لكنه خشي
عليها، لأنه يعرف معنى أن تتزوج البنت ابن عمها ويُكتشف عليها زلة
تتعلق بالشرف، فجأة بينما سلمان في قاعة امتحان الكورس الأول في
الماجستير، إذ تصل إليه رسالة من السيد يخبره بأن خديجة توفيت، أحس
سلمان بألم كبير وجرح عميق كيف له أن يعزي صديقه القريب وهو في
قاعة الامتحان، يأجل السنة أم يأجل العزاء إلى صديقه، بقي هكذا
حتى أتم امتحانه وخرج أول الطلاب، أراد أن يذهب إلا إن الامتحانات
كانت في ذروتها، وما هي إلا ثمانية أيام فيذهب مسرعاً إلى
الكراج ليتجه إلى العمارة، يركب سيارة التكسي يخبر السائق أنه
يريد إلى الماجدية فيسأله السائق عمن يريد من الماجدية، أريد السيد
هاني الناجي، يقول له السائق أتيت للعزاء، قال له نعم، وهل ما زال
جادر عزاء خديجة باقياً للآن؟
يخبره السائق إن جادر خديجة قد نزل ولكن جادر السيد ما زال منصوباً،
صدمة كبرى وحالة من الدهشة يصاب بها سلمان، فهو الذي شعر بتأنيب
كبير لأنه لم يعزي صديقه على وفاة ابنته، فكيف به الآن وصديقه قد
توفي، الكلمات الجنوبية بملوحتها كانت طاغية وحاضرة حضوراً مميزاً،
الكاتب قد مارس عملية الإحياء من جديد وصبغها بصبغ الحداثة، يتحدث
عن الإنسلاخ الكبير الذي تعرض له العراق في بداية العراق الجديد
عام 2003، بدأ الناس يغيرون اسماءهم ويستبدلونها بأسماء أخرى، إن
السرد الغرائبي الذي تميزت به الرواية كان واضحاً منذ السطور
الأولى، إذ التسلسل السردي جرى على وتيرة تصاعدية مشوقة، الحبكة
كانت في الثلث الأخير من الرواية أو الربع الرابع بالتحديد، صحبنا
السرد وكنا نستطلع إلى النهاية التي ستنتهي بها هذه القصة، كنا
نتوقع أن تنتهي بالانفصال وكنا نتوقع أن تموت خديجة لكن موت السيد
لم يكن متوقعاً، إذ الكاتب أختصر حبكته بمفاجئة صادمة لأنه اختصرها
بكلماتٍ معدودة على عدد أصابع اليد الواحدة، كيف يموت السيد ومن
معه في موته، هذه بقيت مجهولة لدينا إلا ما سمعه الراوي من احد
الذين حضروا مجلس العزاء وقال إن السيد مات في الماء، البناء
الهندسي كان متقناً بحرفية عالية، ربما تنفع الذي يدرسون علم
النفس، إنه صراعٌ نفسي كبير كان يعيشه السيد، إلا إن نفسه كبيرة
وسامية فحلقت في ملكوت عالٍ، إن المبادئ لا تموت ولكن تحتاج أن تطبق
وتنشر في عموم الناس لتتعلمها الأجيال جيل عن جيل، كل الرواية كانت
بوهج ناصع وإشعاع يُبعث من بين سطورها، الكلمات لم تُبلى لأنها لم
تفقد برقها ونصوعها، إنها لم تلجأ إلى قاموس الكلمات لتستعير منه
ألفاظاً رنانة موسيقية، بل لجأ الكاتب إلى الفولكلور العراقي ليرى
أنه يحمل من الكلمات المتوهجة قسطاً كبيراً، هذه الحكاية أعطت
دروساً وعبراً بالكرامة، الشهامة، الوفاء، الكرم والحب العذري،
المونولوج الذاتي كان مفعماً بالروح الوثابة الحزينة التي فعل
الهوى فعله وقسى عليها، صراع القلب وما يهوى والمحيط والظروف العامة
كانا على طرفي نقيض تماماً، السيد فقير الحال، هو مجرد موظف في
دائرة لا يجني من المال إلا القليل، فكيف له أن يتزوج احدى
النساء التي تسكن حي المعلمين فهو يخبرها ذات يوم: إذا الله
قسمج إليّ تره راح نموت من الجوع، فتجيبه بصدمةٍ كيف، يقول لها:
ما أكَدر أتخيل أعوفج وأروح للشغل، هكذا كان يعشق السيد ولكن حبه
انتهى بما انتهت به قصته، حاك الكاتب القصة بإسلوب بديع جداً، هو
بنّاء ماهر بعنصر المباغتة والصدمة الطارئة التي يفاجئ بها القارئ
كل حين .