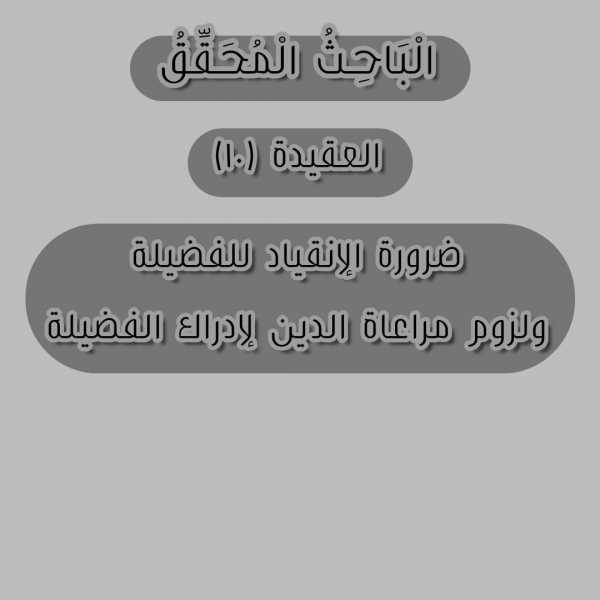#العقيدة_١٠
الدافع العاشر: قاعدة الأنقياد للفضيلة
يمكننا القول إنّ هذه القاعدة هي إعادة صياغة لنظرية شكر المنعم، على
غرار قاعدة اتّباع الحكمة والمعادلة الثلاثية، والفضيلة هي ما يقضي به
الضمير الإنساني الذي هو الهَدي المودع في باطن الإنسان.
ضرورة الإنقياد للفضيلة:
بمعنى مراعاة القيم الأخلاقية وإن أدّت الى بعض النكد والعناء، فلا
يصح في حكم العقل أن يكذب المرء، أو يتعدى على الغير، أو على ماله، أو
يسيء إليه، أو يترك المضطر ليموت وإن كان في ذلك لذة يشعر معها
بالسعادة ولا يخشى منها ضرراً عاجلاً أو آجلاً.
وهذا المعنى من البديهيات التي يجري عليها عامة الناس على الإجمال فإن
القيم الأخلاقية من أصول قواعد السلوك الإنساني.
وتختلف قاعدة الانقياد للفضيلة عن اتباع الحكمة ودفع الضرر بطبيعة
الدافع فيهما، ومثال ذلك من يترك السرقة مع قدرته عليها، فهنا فرضان،
لأنه تارةً يتركها حذراً من انكشاف الأمر والمعاقبة عليها، وذلك من
منطلق اتباع الحكمة، وتارةً يكون تجتب السرقة كراهة للتعدي على مال
الغير ورغبة عن الانتفاع به، وذلك من منطلق الانقياد للفضيلة، فإنه قد
يعتقد المرء جازماً أنه لو سرق لم ينكشف عمله، لكنه لا يفعل منطلقاً
من الاستجابة للعقل القيمي الضمير الإنساني
وتختلف القاعدتان أيضاً في الاتجاه الذي يدفعان إليه الإنسان، فقد
يكون العمل الأخلاقي متساوي في الآثار التي يرجوها المرء أو يحذرها،
فهنا لا تقتضي الحكمة ترجیح أحد الطرفين، ولكن الضمير الإنساني يقتضي
رعاية القيمة الأخلاقية، وأنّ في مراعاة القيمة الأخلاقية عناء ومشقة
أزيد بالقياس إلى ما لو لم يراعها، وحينئذٍ يشعر المرء بالتضحية في
مراعاتها، كمن يعرض نفسه للخطر لإنقاذ الآخرين، وكمن يؤثر الآخرين
بماله بالرغم من حاجته، فالضمير هنا يدعو إلى ممارسة الفعل، ولكن منطق
الحكمة بمعنى تحصيل النفع وتجنب الضر لا يقضي بذلك.
ولكن قد يدّعى أن قاعدة الفضيلة ترجع للحكمة بالنظر إلى أن مراعاة
القيمة الأخلاقية يرافق ضرب من السعادة المعنوية والشعور بالرضا عن
النفس وانتهاكها يوجب ضرباُ من الشقاء النفسي والشعور بالندم والحزازة
ووخز الضمير.
ولكن هذا مخالف للوجدان العام والبداهة العقلية ويفقد التضحية معناها
إذ إنّ التضحية والإيثار بالمال والنفس لأجل الآخرين تجاوزاً للذات
وإهمالا لمآرب النفس، على أننا قد نجد المرء يراعي قيمة معنوية من غير
أن يحدث في نفسه أي حزازة معتدّ بها فيما لو لم يراعها، فمن
يضحي بحياته باحتضان المقدِم على تفجير قنبلة لأجل إنقاذ حياة
الآخرين، قد لا يجد حززة كبيرة توجب تضحيته بنفسه لا سيما إذا كان ذلك
متعارف بين الناس ولا محاسبة عليه، ولكنهم على الرغم من يعرِضون عن
الحياة وملذاتها، ويقدمون على هذه الخطوة الفاضلة.
وقد يقال أنه لا وجود لقيم مغروسة في باطن الإنسان، بل هذه الأحكام
يلقنها الإنسان منذ صغره، فيظن أنها تنبعث من داخله، ولكن هذا الادعاء
أيضاً ينافي الوجدان العام، فإن من المشهود انبعاث القبح والحسن من
ضمير الإنسان، نعم قد يحفز هذا الاستعداد بعد مرحلة الإدراك ولكن هذا
لا يعني أن هذا الاستعداد وليد التربية كما هو الحال في اللغة، حيث إن
الطفل تتكون له لغة لا محالة حتى لو لم يعلمه البالغون لأنها حاجة
إنسانية ماسة.
ولا يبعد أن يقال أن الغاية والمغزى من زرع القيم في داخل الإنسان هو
رعاية المصالح والمفاسد النوعية الدنيوية مضافاً إلى المصالح الأخروية
بحسب المنظور الديني، يدل على ذلك أمران:
١- الاستقراء، فإننا نجد أن المصالح النوعية للإنسان منوطة بالفضائل،
ويتضح ذلك فيما لو فرضنا الإنسان حيادياً تجاه الفضائل، كما لو لم
يتصف بروح محبة الصدق أو روح الوفاء بالالتزامات، وكان معتاداً على
اللامبالاة فإنه ينتج عن ذلك أن لا يثق أحد بأحد، وانهيار الحياة
الإنسانية، وكذا لو لم يكن الإنسان شاكراً بطبعه ولا يشعر تجاه من
أسدى له خدمة وإحساناً بأي إحساس إيجابي، لزهد الناس في إسداء إحسان
إلى الآخرين إلا نادر.
٢- ثبت في علم الأحياء أنّ عامة الإمكانات التي زود بها كل كائن حي
تتجه إلى غاية معينة تقع في مصلحة هذا الكائن، فكثير من مواصفات
الطيور مثلا مرتبة لغاية حفظها وتكاثرها وصيانتها عن صيد أعدائها، بل
حتى النباتات، فالخلقة تتضمن إسعاف كل كائن حي بهدي يوجهه إلى مصالحه
بمقدار میسور ملائم لهذه الحياة.
وهذه القاعدة تنطبق في شأن الإنسان أيضاً، فالمشاعر والعواطف والميول
المودعة في النفس الإنسانية كلها موجهة لصلاحها، فالشعور بالجوع
والتعب مثلاً مجعول في داخل الإنسان صيانة للشخص عن الهلاك، وعليه يصح
القول أنه إذا كان الإنسان يجد من نفسه المشاعر الفاضلة، فإنه يعرف
بعقله أنها تؤمن المصالح النوعية وفق القاعدة الأحيائية المتقدمة.
ولا يصح النقض على هذه القاعدة بالشهوات التي توجب هلاك الإنسان،
لأنها مجعولة في أصلها لغاية فطرية وهي تأمين احتياجات الإنسان وضمان
بقاء نوعه، فالجوع مجعول لأجل أن يكون نذير الحاجة إلى الطعام للبقاء،
وأما المبالغة فيها المؤدية إلى الهلاك فهي ممارسات ناشئة من عدم
سيطرة العقل الحكمي، الذي هو الضابط للإقاعات المختلفة في النفس
الإنسانية.
نعم الميول الشاذة والحالات المرضية خارجة عن هذه القاعدة، فإن
موضوعها ما مُتّع به النوع الإنساني من المشاعر المعتدلة، ومن ثَم فإن
من الخطأ أن يظن أن في بعض الميول الشاذة دلالة على تجويز فطري لتلك
الممارسات، فإنها حالات غير طبيعية، بقرينة منافاتها مع الأعضاء
والآلات التي جهز بها أصحابها، وعليه فهي خروج عن الاستقامة الفطرية
كالعوارض النفسية المرضية وليست جزءا من القانون الإنساني.
والقول بموافقة الفضائل للصلاح النوع الإنساني ليس قبولاً برجوع قاعدة
الانقياد للفضيلة الى اتباع الحكمة والنفع والضرر لوجهين:
١- الذي ذكرناه موافقة الفضائل مع الصلاح النوعي العام للمجتمع وليس
الصلاح الشخصي، واتباع الحكمة في العمل منوط بالصلاح الشخصي، ولا يلزم
من الإتيان بالفضيلة موافقةً لصلاح الفاعل لها، فقد تخالفه في حالات
خاصة.
٢- إنّ الفضيلة وإن ترتب عليها الصلاح والنفع، ولكن دعوة الضمير
الإنساني إليها ليست لأجل المنفعة، وإنما يندفع إليها من إحساس داخلي
بلزوم رعايتها والأخذ بها، فإنّ الإنسان مطبوع على الشعور بالجوع،
ولكنه لا يندفع بالضرورة إلى تناول الطعام من داعي حفظ النفس.
أما بحسب المنظور الديني فيضاف الى ما تقدّم أن من فلسفة طبع الإنسان
على الفضيلة موافقتها مع صلاح الإنسان فيما بعد هذه الحياة، فالفضائل
بذور السعادة المقبلة والرذائل بذور الشقاء المقبل، وكل أمرئ يحصد
غداً نتاج ما زرعه اليوم.
تقدُّم رعاية الفضيلة على اتباع الحكمة:
إن رعاية الفضيلة مقدم في ميزان العقل على رعاية النفع والضرر، أو قل:
إنه ليس من الحكمة راعاية النفع والضرر على خلاف مقتضيات الفضيلة، فلو
علم المرء مثلا أنه لو لم يسرق هذا المال فسوف يقع في ضرر، وإن سرقه
لم يترتب عليه ضرر دنيوي ولا يطلع أحد عليه، فإنه لو علم ذلك فإن
الفطرة تنهاه عن أن يرتكب هذا الفعل، هذا فيما لو قصرنا النظر على هذه
الحياة، حيث إن من الجائز أن تخلو رعاية الفضيلة عن نفع مادي أو توجب
بعض الضرر ومع ذلك تبقى الفضيلة على رجحانها وضرورتها، وأما إذا نظرنا
إلى آثار الأعمال فيما بعد هذه الحياة وفق المنظور الديني فإن رعاية
الفضيلة هي الأوفق بمنفعة فاعلها ودفع المضرة عنه، لأنها توجب له
نفعاً مضاعفاً وتدفع أذى كثيراً في النشأة الاخرى.
تطبيق معادلة الإدراك والمدرَك والمؤونة على
الفضيلة:
قد تؤدي كثرة المؤونة والعناء الى التنزّل عن الإلزام بالفضيلة الى
مستوى الاستحباب والندب، وقد ينتفي رجحان تحصيل فضيلة في حال استلزم
فوات فضيلة أخرى مثلها أو أزيد منها، نعم قد ينتفي داعي الفضيلة في
الحرج والضرر الشديد وحسب مقدار الضرر ونوع الفضيلة، كالكذب على
السارق الذي يسأل عن مكان المال.
أهمية مراعاة الدين لإدراك الفضيلة:
وذلك لأن الرؤية الدينية تقول بأن الله سبحانه خلق الإنسان معنياً به
عناية الوالدين بالولد، ميّزه عن سائر مخلوقاته وسخّر له إمكانات
الحياة، فهو يستوجب شكراً بالإذعان له والتقدير لإنعامه، وأنّ في
الإعراض عنه وتجاهله تنكّر وعقوق وكفران.
وقد جعل سبحانه الحياة مضماراً يأخذ فيه كل إنسان مرتبته بلحاظ درجة
معرفته وشكره: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
وَإِمَّا كَفُورًا)، وبناءً على ذلك فإن الذي يدركه الإنسان بعقله
وضميره أن من واجبه تجاه خالقه شكره سبحانه وتقدير نعمه مراعاة الأدب
في محضره.
ولا ينافي ذلك عدم حاجة الله تعالى إلينا فإنه سبحانه بالرغم من ذلك
يحب أن نتعامل معه بعقلانية وفضيلة بعد أن زودنا بالعقل والضمير لأجل
هذه الغاية، ومثال ذلك -ولله المثل الأعلى- مثل الأب الذي يحب تقدير
ابنه له وتأدبه معه رغم عدم احتياجه له ولتقديره.
المصادر/
١- منهج التثبت في الدين ج٣، ضرورة المعرفة الدينية، السيد محمد باقر
السيستاني.
الباحث المحقق