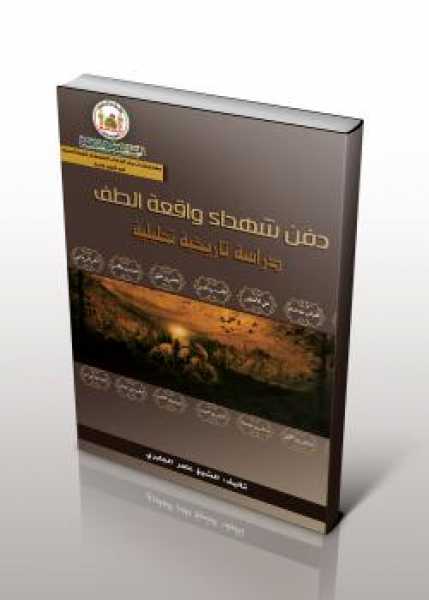دفن شهداء واقعة الطف (دراسة تاريخية تحليلية)
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) صد الله العلي العظيم آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٤.
مقدمة المركز
العلم والقراءة والكتابة بالقلم، قواعد المجد، ومفاتيح التنزيل، وديباجة الوحي، ومشرق القرآن الكريم، بها يقوم الدين، وتُدوّن الشرائع، وتحيى الأمم، وتُبنى الحضارات، ويُكتب التاريخ، ويُرسم الحاضر والمستقبل، وبها تتمايز المجتمعات، وتختلف الثقافات، ويُوزن الإنسان، ويتفاضل الناس، ويزهو ويفتخر بعضهم على البعض الآخر.
في ضوء هذه القيم والمبادئ السامية، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، وبالتوكل على الله تبارك وتعالى، بذلت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة جهوداً كبيرة واهتمامات واسعة لدعم الحركة العلمية والفكرية والثقافية، وتطوير جوانب الكتابة والتأليف والتحقيق والمطالعة، وذلك عن طريق الاهتمام بالشؤون الفكرية، وافتتاح المؤسسات ومراكز الدراسات العلمية، وبناء المكتبات التخصّصية، والتواصل مع الأساتذة والعلماء والمفكّرين، وتشجيع النُخب والكفاءات والطاقات القادرة على بناء صروح العلم والمعرفة.
ويُعدّ مركز الدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية في النجف الأشرف، امتداداً لتلك الجهود المباركة، وقد عمل منذ تأسيسه وبأقسامه ووحداته المتنوّعة على إثراء الواقع العلمي والفكري، وذلك من خلال تدوين البحوث، وتأليف الكتب وتحقيقها ونشرها، وإصدار المجلات المتخصّصة، والمشاركة الفاعلة مع شبكة التواصل العالمية، وإعداد الكوادر العلمية القادرة على مواصلة المسيرة.
ومن تلك الأمور المهمّة التي تصدّى مركزنا المبارك للقيام بها وتفعيلها بشكل واسع، في إطار وحدة التأليف والتحقيق، هي الاهتمام بنشر التراث العلمي والنتاج الفكري والكتابات التخصّصية للعلماء والمحقّقين والباحثين، وذلك بهدف فسح المجال وفتح الأبواب والنوافذ أمام قرّاء الفكر، وطلاب العلم والحقيقة.
ومن تلك النتاجات العلمية والقيّمة، هذا السفر الماثل بين يديك عزيزي القارئ، وهو كتاب (دفن شهداء واقعة الطف) الذي عمل على تأليفه وتحقيقه فضيلة الشيخ عامر الجابري, وقد امتاز هذا الكتاب بجوانب علمية وتحقيقية وفنية عديدة، من أبرزها:
أولاً: سلاسة الأسلوب ووضوح الفكرة.
ثانياً: تسليط الأضواء ـ بصورة مدروسة ومنهجية ـ على حادثة دفن الأجساد الطاهرة لشهداء الطف.
ثالثاً: البحث والتحليل العلمي لتلك الحادثة من زوايا متعدّدة ومختلفة.
رابعاً: الاعتماد في بحوث الكتاب على أهم المصادر العلمية المعتبرة.
نتمنى للمؤلف دوام التوفيق في خدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنه سميع مجيب.
اللجنة العلمية
في مركز الدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
المقدمة
كانت النهضة الحسينية ولا تزال محطّ أنظار المؤرِّخين والأُدباء والباحثين، حتى أنّه يمكن القول: إنّه لا توجد واقعة في تاريخ الإسلام ـ إن لم تكن في تاريخ البشرية جمعاء ـ قد كُتبت حولها من المؤلفات والمصنَّفات، كما كُتب حول واقعة عاشوراء.
وليس في هذا القول مبالغة أو مجانبة للموضوعيّة، فقد حاول الشيخ محمد صادق الكرباسي أن يجـمع الموروث الحسيني في موسوعة ضخمة أطلـق عليها اسـم: (دائرة المعارف الحسينية)، ومن أنّ المتوقع بلوغ هذه الموسوعة الفريدة إلى ما يقرب من ستمائة جزء أو أكثر، وهي بهذا الكمّ الهائل ربما تكون أكبر موسوعة دينيّة عرفتها البشرية لحد الآن، غير أنّ كثيراً من الباحثين في التراث الحسينيّ يرَون أنّ هذا الرقم يعدّ رقماً ضئيلاً مقارنةً بما كُتب عن الحسين عليه السلام، من آلاف المصنَّفات والمؤلفات، وبأفكار ورؤى وتصورات مختلفة ـ كلٌّ على حسب مشربه ـ تناولت شخصيةَ الحسين عليه السلام، وخصائصه ومعطيات نهضته وآثارها... وغير ذلك مما يسمى بالحسينيات([1]).
وربما يتصور بعض الناس ـ بعد سماعه هذا الكلام ـ أنّ الكتابة عن واقعة كربلاء لم تُعدّ ميداناً للإبداع والابتكار؛ فإنّ ألفاً وثلاثمائة واثنين وسبعين عاماً مرّت على هذه الواقعة كفيلةٌ بأن تستوفى جميع جوانب هذه الواقعة بحثاً ودراسة وتقييماً وتنقيباً، إلى غير ذلك من شؤون الكتابة والتدوين.
وهذا التصور غير صحيح، فإنّ كثيراً من تفاصيل وجزئيات واقعة الطفّ لا زالت ميداناً واسعاً للإبداع والابتكار، ولم تعطَ نصيبها الكامل من البحث والكتابة، بل إنّ هناك كثيراً من العناوين التي لا تزال أبكاراً لم تتناولها الأقلام.
وممّا ساعد على بروز هذه الرؤى الخاطئة، وتبنّي هذا الفهم السقيم، هو ما نراه في بعض الكتابات من إعادة للأفكار المستهلكة، واجترار لبعض المفاهيم وتكرارها.
ويرى كاتب السطور أنّ ندرة المادّة التاريخيّة بالنسبة لبعض قضايا (واقعة الطفّ) من جهة، وعدم التفكير الجدّي في تجديد منهج البحث في تاريخ هذه الواقعة من جهة أخرى، هما السبب الحقيقي وراء هذه السلبية التي انطبعت بها الكثير من الكتابات في هذا المجال.
في الحقيقة إنّ الإبداع والابتكار في البحث التاريخي، يكمن في الإبداع والابتكار في المنهج، وبدون التجديد في المنهج فإنّنا سوف نبقى ندور في فلك السابقين، ولن ننتج سوى المكررات والمعادات.
ونحن لا نستطيع في هذه المقدَّمة الموجزة أن نتحدَّث عن المنهج التاريخي الذي نقترحه في التعاطي مع التاريخ الكربلائي، فإنّ هذا الأمر يتطلَّب منّا بسطاً في الكلام لا يتناسب مع صغر حجم هذه الدراسة، ولا يمكن أن نكتفي بإشارة خاطفة حول ذلك، ولعلّنا نوفق في المستقبل القريب إلى تخصيص بحث مستقل ودراسة مفردة نتحدَّث فيها عن (المنهج المقترح في التعاطي مع تاريخ واقعة الطفّ).
ومع ذلك، فإنّ الباحث المتمرِّس في التاريخ الحسيني، والمطَّلع على الإشكاليّات الخاصّة به، سيتعرَّف على كثير من مكونات هذا المنهج، من خلال ما نتقدَّم به من معالجات للفجوات والثغرات التاريخيّة الموجودة في حادثة الدفن، والتي سببها العوز الحاصل في المادة التاريخيّة حول بعض الموارد، كما ألمحنا إلى ذلك فيما مضى.
ولا ريب في أنّ البحث حول حادثة (دفن شهداء واقعة الطفّ) ليس بحثاً جديداً، فقد تكرر هذا العنوان في أغلب مصادر الطفّ قديمها وحديثها، ومع ذلك فإنّني أشعر بأنّ الحاجة لا تزال ماسّة إلى إعادة النظر في هذه الحادثة، وأنّها لا تزال تفتقر إلى مزيد من البحث والدراسة، ليس على صعيد تحقيق هذه الحادثة من الناحية التاريخيّة فحسب، وإنما على صعيد محاولة حلّ بعض رموزها وفهم بعض إشاراتها.
إنّ عمليّة الدفن ـ حسب اعتقادي ـ لم تكن عملية عشوائية، وإنّما كانت عمليّة مقصودة ومدروسة وتحوي على الكثير من الرموز والإشارات، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في هذا الكتيب.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
الشيخ عامر الجابري
تمهيد
قبل الولوج في صميم البحث نرى من الضروري أن نمهِّد لذلك ببيان أمرين مهمين:
الأمر الأول: أهمية البحث.
الأمر الثاني: تبويب البحث وهيكليته.
الأمر الأول: أهمّية البحث
تكمن أهمية البحث حول هذه (الحادثة) في كونها تستبطن ـ إلى جانب بعدها التاريخي ـ بعدين آخرين مهمّين: أحدهما: عقائدي، والآخر فقهي:
1ـ أمّا البعد العقائدي، فإنّنا نعلم أنّ تلك التربة التي احتضنت تلك الجثث الطواهر، قد أصبحت فيما بعد من أشرف بقاع الأرض وأطهرها عند المسلمين، وبمرور الليالي والأيام تحوّلت تلك القفار المحيطة بتلك البقعة إلى مدينة عامرة مقدّسة يؤمُّها الملايين من عشّاق الحسين عليه السلام من كلّ فجٍّ عميق «وامتدّت جاذبية الحسين عليه السلام وصحبه من حظيرة الحائر إلى تخوم الهند والصين وأعماق العجم وما وراء التُرك والديلم، وإلى أقصى من مصر والجزيرة والمغرب الأقصى يرددون ذكرى فاجعته بمرور الساعات والأيام، ويقيمون مأتمه في رثائه ومواكب عزائه، ويجدّون في إحياء قضيته في عامّة الأيام، ويمثِّلون واقعته في ممر الأعوام، هذا بعض ما فاز به حسين النهضة من النصر الآجل، والنجاح في المستقبل»([2]).
ولستُ مجانباً للصواب إذا ما قلت بأنّه لا يوجد في العالم كلّه رمزاً دينيّاً ـ سواء داخل الإسلام أو خارجه ـ تخرج الملايين إلى زيارة قبره، كما تخرج إلى زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام.
2 ـ وأما البُعد الفقهي في حادثة (دفن الشهداء) فهو لا يخفى، وهو يتمثّل بأمرين أساسيين هما:
الأمر الأول: إنّ تشخيص قبور الشهداء يعني ـ فيما يعني ـ تحديداً لموضوعٍ من المواضيع التي يترتّب عليها أحد الأحكام الفقهيّة المستحبة ألا وهو (زيارة الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه)، فالبحث حول حادثة الدفن من هذه الناحية هو بحث عن تحديد موضوع من الموضوعات الفقهيّة، أو بالأحرى هو بحث في متعلّق الموضوع.
الأمر الثاني: وهو متفرِّع عن الأمر الأول، حيث إنّنا بعد تشخيص قبر الإمام الحسين عليه السلام، وقبور سائر الشهداء نستطيع تشخيص وتحديد (الحائر الحسيني) الذي ترتبط به جملة من الأحكام الشرعيّة، وبالرغم من اختلاف الفقهاء في تحديد مساحة (الحائر ) سعةً وضيقاً([3])، إلاّ أنّه لا خلاف في أنّ المرقد الحسينيّ المقدّس يقع في مركز (الحائر)، وعلى ضوء تشخيص وتحديد موقع القبر الشريف نستطيع تحديد مساحة (الحائر) فيما لو بنينا على أحد الآراء المطروحة في البحث الفقهي، والتي يختلف حولها الفقهاء ـ كما أشرنا ـ تبعاً لاختلاف الروايات المحدِّدة لمساحة الحائر الجغرافيّة، ومن هذه الروايات: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «حرم الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربع جوانب»([4]) ([5]). ومنها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أيضاً، قال: «حرم الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر»([6]). ومنها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام كذلك: «قبر الحسين عليه السلام عشرون ذراعاً مكسّراً، روضة من رياض الجنّة»([7]). وغير ذلك من الروايات التي تعرّضت لهذه المسألة.
هناك جملة من الأحكام الشرعيّة المرتبطة بـ (الحائر الحسيني)، وهي:
1 ـ جواز الاستشفاء بطين (الحائر)، وعادة ما يبحث الفقهاء هذا الأمر تحت عنوان (حرمة أكل الطين)([8]).
2 ـ استحباب السجود على التربة الحسينيّة، وهي المأخوذة من داخل حدود (الحائر الحسيني)([9]).
3 ـ استحباب اتخاذ المسبحة من طين (الحائر)([10]).
4 ـ تخيير المسافر بين القصر والإتمام في الصلاة الرباعية في (الحائر الحسيني).
5 ـ حرمة تنجيس تربة (الحائر) متصلة ومنفصلة، وفي هذه النقطة الأخيرة تفصيل لا يسعه المقام([11]).
وعلى ضوء ما تقدَّم ندرك بوضوح أنّ الخوض في حادثة (دفن شهداء واقعة الطفّ) ومحاولة تحريك بعض ثوابتها يعدّ مجازفة ومغامرة تحتاج إلى جرأة في طرح الحقائق والصدع بها.
الأمر الثاني: تبويب البحث وهيكليته
أجمع المؤرِّخون ـ على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم المذهبية ـ على أنّ قوماً من بني أسد كانوا نزولاً بالغاضرية خرجوا لمواراة الجسد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام وسائر شهداء الطفّ، وذلك بعد رحيل عمر بن سعد وانسحاب الجيش الأموي من ساحة المعركة.
وممَن ذكر هذه القضية من مؤرِّخي الشيعة الشيخ المفيد (ت 413 هـ ) في الإرشاد حين قال: « ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد، كانوا نزولاً بالغاضرية إلى الحسين عليه السلام وأصحابه، فصلّوا عليهم ودفنوا ابنه عليّ بن الحسين الأصغر عند رجله، وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين صُرعوا حوله ممّا يلي رجلي الحسين عليه السلام وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً...»([12]).
وابن شهرآشوب في المناقب (ت 588 هـ )، قال: « ودفن جثثَهم بالطفّ أهلُ الغاضرية من بني أسد »([13]).
وقال ابن طاووس في اللهوف (ت 664 هـ ): «ولمّا انفصل عمر بن سعد لعنه الله عن كربلاء خرج قوم من بني أسد فصلّوا على تلك الجثث الطواهر المرمّلة بالدماء، ودفنوها على ما هي الآن عليه»([14]).
وقال الطريحي (ت 1085 هـ ) في منتخبه: «فلمّا ارتحلوا [يعني عمر بن سعد وأصحابه] إلى الكوفة وتركوهم على تلك الحال, عمد أهلُ الغاضرية من بني أسد, فكفّنوا أصحاب الحسين وصلّوا عليهم ودفنوهم»([15]).
وقال السيد محسن الأمين (ت1371 هـ ): «ولمّا رحل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد، كانوا نزولاً بالغاضرية إلى الحسين عليه السلام وأصحابه فصلّوا على تلك الجثث الطواهر ودفنوها...»([16]).
ومن مؤرِّخي أهل السنّة الدينوري (ت282 هـ) في الأخبار الطوال، قال: «قالوا: واجتمع أهل الغاضرية، فدفنوا أجساد القوم»([17]).
والطبري (ت310 هـ ) في تاريخه: «ودفَنَ الحسينَ وأصحابَه أهلُ الغاضرية من بني أسد»([18]).
وقال المسعودي (ت346هـ): «... ودفَنَ أهلُ الغاضرية ـ وهم قوم من بني غاضر من بني أسد ـ الحسينَ وأصحابَه...»([19]).
وقال ابن كثير (ت774 هـ ) في البداية والنهاية: «وقُتل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفساً، فدفنهم أهلُ الغاضرية من بني أسد...»([20]).
ونكتفي بهذا القدر من أقوال المؤرِّخين الناصّة على أنّ أهلَ الغاضرية ـ من بني أسد ـ هم مَن تولّى دفن الأجساد الطاهرة، وهو أمر متسالم عليه بينهم، وإنّما المهم هو البحث في ثلاث مسائل أساسية وقعت مورداً للبحث والنزاع، وهي:
المسألة الأولى: تحديد زمان الدفن.
المسألة الثانية: التخطيط الإلهي لعمليّة الدفن وحضور الإمام السجاد عليه السلام.
المسألة الثالثة: كيفيّة الدفن وتعيين قبور الشهداء.
وفيما يأتي سيتمّ تناول هذه المسائل الثلاث في ثلاثة مباحث على الترتيب المتقدّم، أمّا المبحث الرابع والأخير فقد عُقد للحديث عن الجانب الرمزي والإشاري الذي انطوت عليه هذه الحادثة.
حصل خلاف بين المؤرِّخين في تحديد اليوم الذي ووريت فيه أجساد شهداء الطفّ، فقد انقسموا في هذه المسألة إلى طائفتين رئيستين، ذهبت الطائفة الأولى إلى أنّ الدفن قد حصل في اليوم الحادي عشر من المحرّم، فيما ترى الطائفة الثانية أنّ الدفن قد حصل في اليوم الثالث عشر من المحرّم، فيمكن أن يقال: إنّ في المسألة قولين رئيسين:
القول الأول: دفن الشهداء تمّ في اليوم الحادي عشر من المحرّم:
يظهر هذا القول من جلّ مؤرِّخي أهل السنّة، وفي طليعتهم الطبري والمسعودي([21]) والبلاذري وابن الأثير وابن كثير. وأغلب هؤلاء تابعون للطبري الذي استقى بدوره هذا القول من أبي مخنف، فقد نقل الطبري عن أبي مخنف قوله: «... ودفن الحسينَ وأصحابَه أهلُ الغاضرية من بني أسد بعد ما قُتلوا بيوم»([22]).
قال البلاذري (ت 279هـ): «ودفن أهلُ الغاضرية ـ من بني أسد ـ جثةَ الحسين ،ودفنوا جثثَ أصحابه رحمهم الله بعد ما قُتلوا بيوم»([23]).
وقال المسعودي (ت346هـ): «ودفن أهلُ الغاضرية ـ وهم قوم من بني غاضر من بني أسد ـ الحسينَ وأصحابَه بعد قتلهم بيوم»([24]).
أما ابن الأثير(ت630 هـ ) فقد نقل قول الطبري المتقدِّم بعينه، فلا حاجة إلى إيراده ثانية([25]).
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: «وقُتل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفساً، فدفنهم أهلُ الغاضرية ـ من بني أسد ـ بعد ما قُتلوا بيوم واحد»([26]).
ولم يظهر تصريح من الخوارزمي (ت 568 هـ ) بأنّ دفن الشهداء كان في اليوم الحادي عشر، بل جاءت عبارته مجملة تحتمل عدّة وجوه، قال: «وأقام عمر ابن سعد يومه ذلك إلى الغد، فجمع قتلاه فصلّى عليهم ودفنهم. وترك الحسينَ وأهل بيته وأصحابه، فلمّا ارتحلوا إلى الكوفة وتركوهم على تلك الحالة عمد أهل الغاضرية ـ من بني أسد ـ فكفّنوا أصحابَ الحسين، وصلّوا عليهم، ودفنوهم»([27]).
مؤرّخو الشيعة والدفن في اليوم الحادي عشر:
لم يصدر من مؤرِّخي الشيعة تصريح واضح بأنّ الدفن قد حصل في اليوم الحادي عشر ـ كما هو الحال عند مؤرِّخي أهل السنّة ـ بل كانت عباراتهم مجملة مبهمة، كالشيخ المفيد الذي نقلنا قوله آنفاً حين قال: «ولمّا رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزولاً بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه رحمة الله عليهم، فصلّوا عليهم ودفنوا الحسين عليه السلام حيث قبره الآن، ودفنوا ابنه عليّ بن الحسين الأصغر عند رجليه...»([28])، وكذلك ذهب إلى هذا المعنى السيد ابن طاووس في اللهوف بقوله: «ولما انفصل عمر ابن سعد لعنه الله عن كربلاء، خرج قوم من بني أسد، فصلّوا على تلك الجثث الطواهر المرمَّلة بالدماء، ودفنوها على ما هي الآن عليه»([29]).
ولكن هناك من نسب إليهم القول بأنّ يوم الدفن هو الحادي عشر([30])، إلاّ أنّ هذه النسبة قابلة للنقاش؛ فإنّ كلمات القوم غير صريحة في كون يوم الدفن هو الحادي عشر من المحرّم، وإنّما نصّ هؤلاء المؤرِّخون على حصول الدفن بعد رحيل عمر بن سعد، وليس في كلامهم ما يدلّ على أنّه حصل في نفس اليوم الذي رحل فيه، فيحتمل أن يكون أنّه قد تمّ بعد رحيله مباشرةً يعني في نفس اليوم، ويحتمل أن يكون بعد رحيله بيومين.
ثمّ ستأتي الإشارة إلى اختلافهم في اليوم الذي رحل فيه عمر بن سعد، هل هو اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر؟
وفي الواقع إنّ الإجمال في الكلام يكون جميلاً ومطلوباً في بعض المواضع، وهذا منها، فلعل الدافع الذي دفع بهؤلاء المؤرِّخين إلى هذا الإجمال هو تضارب الأقوال في هذه المسألة، فتكلّموا بالمقدار المتيقّن والجامع المشترك فيها، فإنّ الجميع متّفقون على أنّ الدفن قد حصل بعد رحيل عمر بن سعد وإن اختلفوا بعد ذلك بالمدّة التي تفصل بين الرحيل والدفن.
يضاف إلى ذلك أنّ هذه المسألة ليس بالضرورة أن يعطى رأياً قطعياً فيها؛ لكونها مسألة تاريخية بحتة ولا يترتّب عليها أثر عقائدي أو شرعي أو أخلاقي.
نعم، يظهر من ابن شهر آشوب في المناقب أنّ الدفن كان في اليوم الحادي عشر من المحرّم؛ إذ قال: «... ودفن جثثَهم بالطفّ أهلُ الغاضرية من بني أسد بعد ما قُتلوا بيوم، وكانوا يجدون لأكثرهم قبوراً ويرون طيوراً بيضاً... » ([31]).
وهذا النصّ قد اقتبسه ابن شهر آشوب ـ على ما يبدو ـ من تاريخ الطبري، ولكننا حينما نراجع تاريخ الطبري المتداول لا نجد فيه عبارة «وكانوا يجدون لأكثرهم قبوراً ويرون طيوراً بيضاً».
والظاهر أنّ النسخة التي وصلت إلى ابن شهر آشوب من تاريخ الطبري تختلف في بعض الموارد عن النسخة المتداولة؛ فإنّ لابن شهر آشوب إسناده الخاص إلى تاريخ الطبري. حيث إنّه يرويه عن القطيفي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عمرو بن محمد، بإسناده عن محمد بن جرير بن يزيد الطبري([32]).
القول الثاني: دفن الشهداء في اليوم الثالث عشر من المحرم:
وهو القول المشتهر على ألسنة المتأخرين والمعاصرين من مؤرِّخي الشيعة، يقول السيد محسن الأمين في كتابه المجالس السَّنية: «... فبقيت جثّة الحسين عليه السلام وجثث أصحابه بلا دفن ثلاثة أيام»([33]).
ويقول السيد عبد الرزاق المقرَّم: «وفي اليوم الثالث عشر من المحرَّم أقبل زين العابدين لدفن أبيه الشهيد عليه السلام؛ لأنّ الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله»([34]).
وفي الخصائص الحسينيّة للتستري: «... وأمّا أهل هذه النشأة، فأول من زاره بعد دفنه سيد الساجدين عليه السلام حين دفنه بعد ثلاثة أيام مع جماعة من بني أسد»([35]).
ويقول في موضع آخر من الخصائص: «ولا يبعد أن تكون زيارة يوم الثالث عشر مخصوصة أيضاً، فإنّه يوم دفنه صلوات الله تعالى عليه، وعلى الأرواح التي حلَّت بفنائه»([36]).
ويقول المظفر: «فقد شاع واشتهر على ألسنة المؤرِّخين واقتبسه منهم الشعراء أنّ الحسين عليه السلام بقي ثلاثة أيام بلا دفن»([37]).
ويقول محمد مهدي الحائري في شجرة طوبى مخاطباً ومعاتباً أمير المؤمنين عليه السلام: «... يا أمير المؤمنين يعزّ علينا معشر المحبِّين بأن توافي سلمان من المدينة إلى المدائن، وتغسّله بيدك وتحنّطه وتكفّنه وتدفنه، ويبقى ولدك الحسين طريحاً جريحاً ملقى على الرمضاء بلا غسل ولا كفن ملقًى ثلاثاً ...»([38]).
وقال متسائلاً في موضع آخر من نفس الكتاب: «... ألم يبذل الحسين جميع ماله وعياله وأولاده في سبيل الله؟! بقيت جنازته ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن!»([39]).
وقال في موضع ثالث: «مات الغريب، وهو إذ ذاك سيد الخلق وأشرفهم واتقى الله، وهو أبو الأرامل واليتامى، بقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن ولا دفن»([40]).
الرأي الراجح في مسألة زمان الدفن هو اليوم الثالث عشر:
ومع أنّني بذلت مجهوداً كبيراً في تصفح مصادر واقعة الطفّ القديمة والحديثة، إلا أنّني لم أقف على المصدر التاريخي الأوّل الذي أخذ عنه هذا القول، بل إنّني أكاد أجزم بأنّه لا يوجد أحد من مؤرِّخي الشيعة القُدامى قد نصَّ على هذا القول بشكل صريح، ومع ذلك فإنّ هذا القول يمكن أن يُدعم بعدّة أمور.
شواهد ومؤيدات لحصول الدفن في اليوم الثالث عشر:
توجد عدّة شواهد ومؤيدات يمكن أن تؤلِّف بمجموعها دليلاً على أنّ اليوم الثالث عشر هو اليوم الذي دُفنت فيه أجساد الشهداء، ومن هذه الشواهد والقرائن:
أولاً: اشتهاره على ألسنة أُدباء الطفّ
إنّ دفن شهداء كربلاء بعد ثلاثة أيام من شهادتهم له حضور بارز في أدب الطفّ، وينبغي أن نتحدَّث عن ذلك ضمن النقاط التالية:
1ـ لعل أقدم مَن نَظَم هذا المعنى من أدباء الطفّ هو سيف بن عميرة النخعي الكوفي؛ وذلك في قصيدة طويلة له يرثي بها الحسين عليه السلام، يقول في أولها:
|
جلّ المصاب بمَن أصبنا فاعذري |
|
يا هذه وعن الملامة فاقصري |
إلى أن يقول في البيت الثالث عشر من القصيدة، والذي فيه محل الشاهد:
|
عارٍ بلا كفن ولا غسل سوى
|
|
مور الرياح ثلاثة لم يقبر([41])
|
وعميرة هذا هو أحد أدباء الطفّ في القرن الثاني الهجري كما نصّ على ذلك صاحب موسوعة أدب الطفّ([42])، وقد عدّته الموسوعات الرجالية في عداد الفقهاء والمشايخ الثقات، من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.
ويكفي أن نذكر هنا ما قاله السيد بحر العلوم في حقّه: «سيف بن عميرة النخعي: عربي كوفي أدرك الطبقة الثالثة والرابعة، وروى عن الصادق والكاظم عليهما السلام، وهو أحد الثقات المكثرين والعلماء المصنِّفين، له كتاب، وروى عنه مشاهير الثقات، وجماهير الرواة، كإبراهيم بن هاشم، وإسماعيل بن مهران، وأيوب بن نوح، والحسن ابن محبوب، والحسن بن علي بن أبي حمزة، والحسن بن يوسف بن بقاح، وابنه الحسين بن سيف، وحماد بن عثمان، والعباس بن عامر، وعبد السلام بن سالم، وعبد الله بن جبلة، وعلي بن أسباط، وعلي بن حديد، وعلي بن الحكم، وعلي بن سيف ـ والأكثر عن أخيه عن أبيه ـ وعلي بن النعمان، وفضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن خالد الطيالسي، ومحمد بن عبد الجبار، ومحمد بن عبد الحميد، وموسى بن القاسم، ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم»([43]).
وفي ضوء التأمل فيما قيل في ترجمة هذا الرجل، يستبعد أن يتلفظ ما تلفظ به دون أن يكون له ما يستند إليه، وإذا كنا نأخذ بأقوال هذا الرجل في مجال الفقه والشريعة، فمن باب أولى أن نأخذ بأقواله في مجال التاريخ، ومن المحتمل أن يكون قد سمع هذا المعنى وتلقَّاه من الإمام الصادق أو الكاظم عليهما السلام.
ولكن ممّا ينبغي الاعتراف به، هو أنّه لا يوجد من تطرّق إلى هذا المعنى سوى سيف بن عميرة في حدود ما وصل إلينا من أدب الطفّ المنتمي للقرون الثلاثة الأولى.
ومع ذلك (فإنّ عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود)؛ فإنّ جزءاً كبيراً من تراثنا الأدبي الحسينيّ قد تعرَّض إلى الضياع والتلف، ووراء ذلك عوامل مختلفة وأسباب متنوعة لا يسعنا الوقوف عليها في هذه العجالة([44]).
2 ـ في القرن الرابع الهجري جاء هذا المعنى أيضاً على لسان الشريف الرضي، حيث جاء في قصيدته الرائية:
|
لله ملقى على الرمضاء به |
|
فم الردى بين إقدام وتشميرِ |
|
تحنو عليه الربى ظلاً وتستره
|
|
عن النواظر أذيال الأعاصيرِ
|
|
تهابه الوحش أن تدنوا لمصرعه
|
|
وقد أقام ثلاثاً غير مقبورِ([45]) |
والشريف الرضي صاحب هذه الأبيات: «هو السيد الأجلّ أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، أخو الشريف المرتضى، أمرُه في العلم والفضل والأدب والورع وعفّة النفس وعلو الهمّة والجلالة أشهر من أن يذكر»([46]).
وللشريف الرضي كتب عديدة منها: كتاب نهج البلاغة، حقائق التأويل، تلخيص البيان من مجازات القرآن، معاني القرآن يتعذر وجود مثله، مجازات الآثار النبوية، خصائص الأئمة، ديوانه أربع مجلدات([47]).
فلم يكن الشريف الرضي مجرد شاعر أو أديب، بل هو في عداد علمائنا المتقدِّمين. ومن المستبعد أن يضمِّن شعرَه وقائع تاريخية من دون أن يكون له حجّة فيها؛ ولذا لا يمكن التقليل من أهمّية الاستشهاد بهذه الأبيات بحجّة أنّ كتب الأدب تحظى بقيمة ثانوية وهامشية فيما يخصّ الأحداث التاريخية في واقعة الطفّ. فإنّ هذا الكلام ـ على اطلاقه ـ لا يسلم من المناقشة.
4 ـ وفي كتاب كامل الزيارات ـ الذي يعود تأليفه إلى القرن الرابع الهجري ـ أورد مؤلفه المعنى المشار إليه على لسان الجنّ، حيث قال: حدَّثني حكيم بن داود ابن حكيم، عن سلمة، قال: حدَّثني أيوب بن سليمان بن أيوب الفزاري، عن علي ابن الحزور، قال: سمعت ليلى، وهي تقول: سمعت نَوح الجنّ على الحسين بن علي عليهما السلام وهي تقول:
|
يا عين جودي بالدموع فإنّما |
|
يبكي الحزين بحرقة وتفجع
|
|
يا عين ألهاك الرقاب بطيبة
|
|
من ذكر ىل محمد وتوجع
|
|
باتت ثلاثاً بالصعيد جسومهم
|
|
بين الوحوش وكلهم في مصرع([48])
|
وسواء كنت ـ أيها القارئ الكريم ـ تعتقد بصحّة نسبة هذه الأبيات إلى الجنّ أوكنت تعتقد بلزوم تأويلها، كما ذهب إلى ذلك الشهيد مرتضى مطهري في الملحمة الحسينيّة([49])، ففي كلا الحالين تبقى هذه الأبيات نصاً تاريخياً يدلّ على وجود من يتبنّى الرأي المشار إليه قبل القرن الرابع الهجري.
5 ـ حسب تتبعنا لموسوعات أدب الطفّ لا يوجد من أشار إلى هذا المعنى في القرون (الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع)، أو على الأقل أنّه لم يصل إلينا؛ لأنّ (عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود)، كما ألمحنا سابقاً.
وقد بدأ هذا المعنى بالذيوع في أدب الطفّ وبنحو تدريجي مع بدايات القرن العاشر، بحيث إنّنا كلّما تقدَّمنا في القرون الأخيرة، ازداد هذا المعنى حضوراً على ألسن الأدباء.
والملاحظ أنّ شيوع هذا المعنى في أدب الطفّ في القرون الأخيرة، جاء متزامناً مع التزامه كرأي من قبل المتأخرِّين من مؤرِّخي الشيعة.
وعلى أية حال، فإنّ ما نُظم في هذا المعنى خلال هذه الفترة أكثر من أن نُمثِّل له أو نستشهد له بنماذج على أنّ هذه الشواهد والنماذج مع كثرتها لا تنفعنا في المقام؛ لأنّ قائليها قد يكونون قد تأثّروا بشيوع هذا الرأي على ألسنة مؤرِّخي الشيعة المتأخرين.
ثانياً: الخلل في دلالة وصحّة قولهم إنّ الدفن كان في اليوم الحادي عشر
إنّ التحليل الدقيق لما قاله أصحاب القول الأوّل يُظهر لك فسادَ هذا القول وبُعده عن الصواب؛ فإنّ المؤرِّخين قد أجمعوا ـ بما فيهم أصحاب هذا القول ـ على أنّ الدفن قد حصل بعد رحيل عمر بن سعد، وقد اتّفق المؤرِّخون على أنّ رحيله قد تمّ بعد اليوم العاشر، حيث ذهبت أكثر المصادر إلى القول بحصول الرحيل في اليوم الحادي عشر([50]). وذهبت مصادر أخرى إلى القول بحصوله في اليوم الثاني عشر([51]). وبالجملة يمكن القول: إنّ هناك اتّفاقاً بين المؤرِّخين على عدم حصول الرحيل قبل اليوم الحادي عشر؛ فليس من المعقول أنّ بني أسد قد قاموا بعملية الدفن في نفس اليوم الذي تمّ فيه الرحيل، خصوصاً إذا التفتنا إلى بعض النقول التي تقول إنّهم لم يكونوا في قريتهم آنذاك. إلاّ أنّه يجوز على أساس هذا التحليل أن يكون الدفن قد حصل في اليوم الثاني عشر، وهذا ما احتمله بعض الباحثين، كالمظفر في كتابه بطل العلقمي، وهو الظاهر من كلام هبة الدين الشهرستاني في كتابه نهضة الحسين عليه السلام، وصالح الشهرستاني في تاريخ النياحة.
قال المظفر: «وهنا نفهم أن لا يتمّ لهم رحيل إلا ليلة الثاني عشر ولا تبلغ الأخبار برحيلهم إلى بني أسد إلاّ يوم الثاني عشر، لانقطاع المارّة هيبة ورهبة للجيش، فإن كانوا في حيهم نزولاً، فقد يجوز أنّهم دفنوهم في اليوم الثاني عشر، وهو ثالث يوم قتلهم؛ فيكون بقاؤهم بلا دفن يومان ونصف»([52]).
وقال هبة الدين الشهرستاني: «هذا وما عتمت عشية الثاني عشر من محرَّم، إلاّ وعادت إلى أرياف كربلاء عشائرها الظاعنة عنها بمناسبة القتال، وقطّان نينوى والغاضريات من بني أسد ـ وفيهم كثير من أولياء الحسين عليه السلام، وقليل ممّن اختلطوا برجالة جيش الكوفة ـ فتأملوا في أجساد زكية تركها ابن سعد في السفوح وعلى البطح تسفي عليها الرياح، وتساءلوا عن أخبارها العرفاء، فما مرّت الأيام والأعوام إلاّ والمزارات قائمة، وعليها الخيرات جارية، والمدائح تُتلى، والحفلات تتوالى، ووجوه العظماء على أبوابها، وتيجان الملوك على أعتابها...»([53]).
وجاء في تاريخ النياحة لصالح الشهرستاني: «ما عتمت عشية اليوم الثاني عشر من المحرّم سنة61 هـ ـ أي اليوم الثالث على استشهاد الإمام وصحبه وآله ـ إلاّ وكانت قد عادت العشائر التي كانت تحيط بمنطقة القتال في كربلاء، والتي كانت قد ظعنت مؤقتاً عنها بمناسبة القتال، وهي عشائر بني عامر من قبائل بني أسد من سكّان قريتي الغاضرية ونينوى، وكانت أكثريّتها تُشايع آل بيت النبوة صلى الله عليه وآله وتوالي الحركة الحسينيّة، فبادرت هذه العشائر فور عودتها إلى التعرُّف على أجساد المستشهدين الزكية، التي تركها ابن سعد في العراء تسفي عليها الرياح، ثمّ أخذ أفراد هذه العشائر يحفرون للأجساد الحُفَر اللازمة، وقد دَفنوا فيها أشلاءها الممزقة» ([54]).
ثالثاً: حضور الإمام زين العابدين عليه السلام عمليةَ الدفن
ومن القرائن الأُخرى ـ التي ذكرها بعض الباحثين ـ المرجِّحة لحصول الدفن في اليوم الثالث عشر هي حضور الإمام زين العابدين عليه السلام مع الأسديين لمواراة الأجساد؛ حيث تذكر روايةُ مناظرة الإمام الرضا عليه السلام مع الواقفة ـ والتي سننقلها في المبحث القادم ـ: أنّه عليه السلام قد حضر إلى الطفّ بأسلوب إعجازي، فخرج من سجن ابن زياد وهم لا يعلمون.
والمظنون أنّ زين العابدين عليه السلام قد دخل إلى السجن في اليوم الثالث عشر([55]).
وهذا الظنّ بحضور الإمام زين العابدين عليه السلام في الثالث عشر من المحرّم مستنتَج من عدّة شواهد وقرائن تاريخيّة:
القرينة الأُولى: نصّت أكثر المصادر على حصول الرحيل في اليوم الحادي عشر ـ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ـ وقد نصّ بعضهم على حصوله بعد الزوال([56]).
القرينة الثانية: هناك بعض الشواهد والقرائن تكشف عن وصول الجيش والعائلة إلى الكوفة في النهار؛ فيكونون قد باتوا ليلة الثاني عشر في منزل قريب من الكوفة، ودخلوا الكوفة في اليوم الثاني عشر.
وقد اعتبر صاحب الركب الحسيني أنّ أهمّ تلك الشواهد والقرائن هي:
1ـ حساب المسافة وسرعة الدواب في ذلك العصر، فإنّ الأرجح أنّ عمر ابن سعد ومن معه يمسون عند مشارف الكوفة أول الليل ـ أي ليلة الثاني عشر ـ هذا إذا كانوا قد جدّوا السير إلى الكوفة.
2ـ إنّ دخوله الكوفة نهاراً لا ليلاً أمر يقتضيه العامل الإعلامي، وزهو الانتصار، والمباهاة بالظفر في صدر كلّ من ابن زياد وابن سعد وأعوانهما.
3ـ وجود بعض الإشارات التاريخيّة، التي تفيد أنّ دخولهم الكوفةَ كان نهاراً لا ليلاً([57]).
القرينة الثالثة: انشغال الإمام زين العابدين عليه السلام والعائلة في اليوم الذي دخلوا فيه الكوفة بعدّة أشياء، كعرضهم على ابن زياد لعنه الله، وإلقائهم للخطب وما إلى ذلك.
فمن مجموع هذه الشواهد والقرائن يمكن أن نستنتج أنّ أول أيام سجن الإمام زين العابدين عليه السلام والعائلة في الكوفة هو اليوم الثالث عشر من المحرّم.
وبما أنّ الإمام الرضا عليه السلام قد أشار ـ كما سيأتي ـ في مناظرته مع الواقفة أنّ حضوره إلى الطفّ كان إعجازياً؛ فخرج من سجن ابن زياد وهم لا يعلمون، فيستنتج من كلّ ذلك أنّ حضوره إلى الطفّ كان في اليوم الثالث عشر.
رابعاً: عمل الطائفة على أنّ الدفن في اليوم الثالث عشر
إنّ عمل الطائفة الإمامية إلى اليوم مبني على أنّ يوم الدفن هو الثالث عشر من المحرّم «ففي كلّ عام من أعوام الشيعة الثالث عشر من المحرّم تشاهد موكب التمثيل الفخم يضم ألوف الممثِّلينَ من الرجال والنساء يحملون القرب والمساحي والمعاول يهرعون إسراعاً بالعويل والصراخ إلى الحائر الحسيني، فترى نفسك والحال هذه كأنّك بين الأسديين القدامى، الذين أنهضتهم الحفاظ وقادهم الحماس الديني لمواراة آل الرسول صلى الله عليه وآله»([58]).
وهذه السيرة العمليّة الممتدّة في عمق التاريخ لا يمكن أن تكون بلا أصل معوَّل عليه، لاسيما إذا التفتنا إلى أنّها كانت ولا تزال تجري في المدن المقدَّسة، وتحت أنظار فقهاء الطائفة وأساطين المذهب، مع أنّ أياً منهم لم يعترض عليها ولم ينهَ عنها.
ينبغي ألاّ يغيب عن بال كلّ من يؤمن بتوحيد الله سبحانه ـ بكل أنواعه وأشكاله ـ أنّ حركة هذا الكون الفسيح وما يضم من عجائب قدرته سبحانه وبديع صنعه، تتمّ بتخطيط وتنظيم دقيق من قبل الخالق جلّ وعلا، فكلّ جزيئة من جزيئات هذا العالم لها وظيفتها، وتسير نحو هدفها المعدّ لها، والبشريّة بطبيعة الحال غير خارجة عن هذا التخطيط، فإنّها تسير نحو كمالها ورقيها في ضمن حركة ونظام دقيق، وما بعثُ الأنبياء ونزول الأديان والرسالات السماوية إلاّ فصول مهمّة في هذا السفر.
وعندما وصلت البشريّة إلى مرحلة من التكامل والرقي أهّلتها لأن تتلقّى الرسالة الإسلامية الخاتمة، التي جاء بها سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم صلى الله عليه وآله، ومع هذا كانت الأمّة الإسلامية بحاجة ماسّة إلى أن تجتاز بعض العقبات والمطبات في طريق سيرها، ولعلّ أهم اختبار تعرّضت له الأمّة الإسلامية، وهزّت وجدانها، ألا وهي حادثة كربلاء، التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، والتي صبغت جدران التاريخ بلونها الأحمر القاني.
حادثة عاشوراء والتخطيط الإلهي:
إنّ واقعة عاشوراء حلقة أساسية من حلقات التخطيط الإلهي لتكامل البشريّة؛ ولذا استوجب تدخّل المعصومين عليهم السلام ليخططوا لهذه الواقعة، ويسهموا في الإعداد لها قبل وقوعها بعقود، وذلك بأمر من الله تعالى، وتوجد في هذا المعنى روايات عديدة أدرجها علماؤنا في كتبهم الحديثيّة، وقد عقد الكليني في الكافي باباً مستقلاً بعنوان: «إنّ الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزونه»([59]). وهذا العنوان الطويل الذي وضعه الكليني لهذا الباب، هو عبارة عن الخلاصة النهائية التي يستنتجها جميع من طالع تلك الروايات.
وعلى سبيل النموذج والمثال نذكر من تلك الروايات ما رواه «عن محمد بن يحيى والحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسين ابن علي، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جميلة، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ الوصية نزلت من السماء على محمد كتاباً، لم ينزل على محمد صلى الله عليه وآله كتاب مختوم إلاّ الوصية، فقال جبرئيل عليه السلام: يا محمد، هذه وصيتك في أمّتك عند أهل بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال: نجيب الله منهم وذريته، ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم عليه السلام وميراثه لعلي عليه السلام وذريتك من صلبه. قال: وكان عليها خواتيم، قال: ففتح علي عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما فيها، ثمّ فتح الحسن عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمر به فيها، فلمّا توفي الحسن ومضى فتح الحسين عليه السلام الخاتم الثالث، فوجد فيها أن قاتلْ فاقتلْ وتُقتل واخرج بأقوام للشهادة، لا شهادة لهم إلاّ معك. قال: ففعل عليه السلام...»([60]).
ومنها ما رواه «عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال له حمران: جعلت فداك أرأيت ما كان من أمر عليّ والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز وجل، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم، حتى قُتلوا وغلبوا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران، إنّ الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه، ثمّ أجراه، فبتقدُّم علم ذلك إليهم من رسول الله قام عليّ والحسن والحسين، وبعلمٍ صمتَ من صمتَ منّا»([61]).
ومنها ما رواه «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي عبد الله البزاز، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جُعلت فداك ما أقلّ بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم؟! فقال: إنّ لكلّ واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدّته، فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أنّ أجله قد حضر؛ فأتاه النبي صلى الله عليه وآله ينعى إليه نفسه، وأخبره بما له عند الله، وإنّ الحسين عليه السلام قرأ صحيفته التي أعطيها، وفسّر له ما يأتي بنعي، وبقي فيها أشياء لم تقضِ، فخرج للقتال، وكانت تلك الأُمور التي بقيت أنّ الملائكة سألت الله في نصرته، فأذن لها ومكثت تستعدّ للقتال وتتأهب لذلك حتى قتل، فنزلت وقد انقطعت مدّته وقُتل عليه السلام، فقالت الملائكة: يا رب، أذنت لنا في الانحدار وأذنت لنا في نصرته، فانحدرنا وقد قبضته، فأوحى الله إليهم: أن الزموا قبره حتى تروه وقد خرج فانصروه، وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته، فإنّكم قد خُصصتم بنصرته وبالبكاء عليه، فبكت الملائكة تعزياً وحزناً على ما فاتهم من نصرته، فإذا خرج يكونون أنصاره»([62]).
بل المستفاد من كثير من المرويات أنّ الإعداد لهذه الواقعة قد سبقها بقرون، وأنّ للأنبياء عليهم السلام دور بارز في هذا الإعداد، وقد تجلّى هذا الدور على عدّة مستويات:
المستوى الأول: الحزن والبكاء.
المستوى الثاني: المواساة.
المستوى الثالث: الزيارة.
المستوى الرابع: لعن قتلة الحسين عليه السلام([63]).
في الوقت الذي يصرّ فيه الكثير من الكتّاب والباحثين على تفسير أحداث واقعة الطفّ تفسيراً ظاهرياً بشرياً، وأنّها حركة عفوية وردّة فعل حيال الأحداث، فإننا نصرّ على التفسير الغيبي لهذه الواقعة «وأنّ الله سبحانه وتعالى قد عهد للإمام الحسين عليه السلام، وأمره ـ عن طريق النبي صلى الله عليه وآله ـ بتنفيذ مشروع ينتهي باستشهاده واستشهاد من معه، وجميع ما حدث من مآسٍ وفجائع. وكان له عليه السلام ـ بما يمتلك من مؤهلات ذاتية وشخصيّة ـ الدور المتميز في تنفيذ المشروع المذكور وفاعليته، وتحقيق أهدافه السامية»([64]).
بل إنّنا لا نغالي إذا قلنا: بأنّ جميع تفاصيل وفصول هذه الواقعة المقدّسة قد حدثت بتخطيط وتنفيذ السماء.
والتفسير الغيبي لواقعة الطفّ لا يعني بالضرورة إلغاء الآثار والنتائج الضخمة التي ترتّبت على واقعة الطفّ، كما لا يتنافى بأي حال من الأحوال مع الطبيعة البشرية لعمل الأنبياء والأوصياء، كما أنّه ليس المراد من التفسير الغيبي أنّ هذه الواقعة غير قابلة للفهم البشري([65]).
فجميع هذه التحفّظات التي أوردت على التفسير الغيبي لواقعة الطفّ ناشئة من لبس في مفهوم (التفسير الغيبي) وعدم فهم المراد منه فهماً صحيحاً.
فهؤلاء يتصورون أنّ المقصود من التفسير الغيبي للحادثة هو ما يقابل التفسير الفلسفي والعلمي لها كما هو مصطلح عليه في الاتّجاه الاجتماعي، الذي أسّسه (أوجست كونت) (ت 1857م)([66])، وهذا التصور غير سليم.
إنّ مرادنا من التفسير الغيبي لواقعة الطفّ، هو أنّ هذه الواقعة وما سبقها من مقدِّمات قريبة وما لحقها من أدوار ـ ترتبط بها ـ قام بها المعصومون عليهم السلام إنّما حصل ذلك بتخطيط السماء وتنفيذها.
وعلى العكس ممّا يتصوره هؤلاء الباحثون، فإنّ التفسير الغيبي لا يعني ـ أبداً ـ غلق باب التفكير والتأمل في أسباب ودوافع أحداث هذه الواقعة، بل إنّه يدفعك إلى التفكير والتأمل في كلّ جزئية من جزئياتها، ويحثّك على معرفة الأسباب والدوافع لكلّ صغيرة وكبيرة فيها، ولكن بشرط أن تفهم هذه الواقعة فهماً إلهيّاً لا فهماً بشرياً, وأن تتجنب التعامل معها بالمنهج البشري الأرضي، الذي يحاول البعض تطبيقه على واقعة الطفّ.
طريقة دفن شهداء الطفّ تخطيط إلهي:
إنّ من بين المسائل التي نعتقد بشمول هذا التخطيط الإلهي السماوي لها هي مسألة دفن شهداء واقعة عاشوراء؛ فإنّها بلا شك لم تكن بتخطيط وتنفيذ من أهل الغاضرية بمفردهم، وإنّما كانت عملية إلهية سماوية على مستوى التخطيط والتنفيذ على حدّ سواء.
يقول بعض الباحثين: «إنّ طريقة دفن الإمام عليه السلام وأهل بيته وأصحابه المستشهدين بين يديه صلوات اللّه عليهم أجمعين على النحو والتوزيع المعروف من خلال قبورهم ـ والمتسالم عليه بلا خلاف ـ لا يمكن لبني أسد من أهل الغاضرية ـ وهم من أهل القرى الذين لم يشهدوا المعركة ـ أن يحققوا ذلك بدون مرشد عارف تماماً بهؤلاء الشهداء وبأبدانهم ولباسهم، خصوصاً وأنّ الرؤوس الشريفة كانت قد قُطعت وبقيت الأجساد الشريفة بلا رؤوس، فلولا هذا المرشد المطَّلع العالم لما أمكن لبني أسد من أهل الغاضرية التمييز بين شهيد وآخر، ولولاه لكان الدفن عشوائياً بلا معرفة، ولم يكن ليتحقق هذا الفصل المقصود وهذا التوزيع المدروس بين هذه القبور على ما هي عليه الآن»([67]). وسنشير فيما بعد في المبحث الرابع إلى بعض ما نفهمه من أسرار هذا التخطيط.
بعد ما تبيّن لنا أنّ عمليّة دفن شهداء الطفّ ـ لكونها جزءاً من واقعة عاشوراء ـ لا تخرج عن التخطيط الإلهي، فلا بدّ حينئذ من آلية وأسلوب معيّن يحصل بواسطته تنفيذ هذا المخطط، ومن خلال ما لدينا من معطيات وشواهد يمكننا أن نتصور نوعين من آليات وأساليب تنفيذ المراد الإلهي:
الآلية الأولى: الأُسلوب الغيبي البحت
استناداً إلى بعض الدلائل ـ المتوفّرة بالإمكان ـ نقول: إنّ هناك أسلوباً غيبياً بحتاً، وتدخُّلاً مباشراً من الله سبحانه ساهم في أن تحصل كيفيّة دفن الشهداء بهذه الكيفيّة التي نراها اليوم، ومن هذه الدلائل ما ورد عن ابن شهر آشوب من خبر ـ أشرنا إليه سابقاً ـ والذي يقول فيه: «ودفن جثثهم بالطفّ أهلُ الغاضرية من بني أسد بعد ما قُتلوا بيوم، وكانوا يجدون لأكثرهم قبوراً ويرون طيوراً بيضاً»([68])، فإنّه وإن صرّح بأنّ المباشر للدفن هم أهل الغاضرية، إلاّ أنّ ذيل الرواية يكشف بوضوح عن تدخُّل السماء في تحديد وتشخيص أجداث الشهداء.
وكذلك ما جاء في خبر أم سلمة الذي أورده الشيخ الطوسي في أماليه، حيث يروي بسنده، «عن عبد الله بن عباس، قال: بينا أنا راقد في منزلي إذ سمعت صراخاً عظيماً عالياً من بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، فخرجتُ يتوجه بي قائدي إلى منزلها، وأقبل أهل المدينة إليها ـ الرجال والنساء ـ فلما انتهيت إليها، قلت: يا أم المؤمنين، ما بالك تصرخين وتغوثين؟! فلم تجبني، وأقبلتْ على النسوة الهاشميات، وقالت: يا بنات عبد المطلب، اسعدنني وابكين معي، فقد والله قُتل سيدكن وسيد شباب أهل الجنّة، قد والله، قُتل سبط رسول الله وريحانته الحسين. فقيل: يا أم المؤمنين، ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام الساعة شعثاً مذعوراً، فسألته عن شأنه ذلك، فقال: قُتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم، والساعة فرغت من دفنهم...»([69]).
وإذا كنت لا تقبل بحصول مثل هذه الأمور التي لم تكن عزيزة على الله سبحانه، فإنّ لدينا أسلوباً آخر في حصول كيفيّة الدفن، وهي حضور الإمام زين العابدين عليه السلام وتوليه بنفسه عمليّة الدفن بمساعدة أهل الغاضرية من بني أسد، ولنا على ذلك شواهد وأدلّة سنتعرّض إلى ذكرها في المبحث القادم.
الآلية الثانية: حضور الإمام زين العابدين عليه السلام
من القضايا التي لا يختلف عليها اثنان من أتباع أهل البيت عليهم السلام، هو أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام قد حضر إلى كربلاء في اليوم الثالث عشر من المحرّم؛ من أجل مواراة أجساد الشهداء، وقد كان حضوره حضوراً إعجازيّاً، وهو ما يعبِّر عنه العرفاء بطيّ الأرض؛ لأنّه كان مسجوناً في الكوفة آنذاك.
والسبب في ترسيخ هذا التصوّر في أذهان العامّة: هو أنّ خطباء المنبر الحسيني حينما يطرحون هذه القضية يطرحونها بشكل يوحي بأنّها قضية قطعيّة ومسلَّم بصحّتها بين مؤرِّخي الشيعة، مع أنّ هذا التصور عن هذه القضية غير صحيح، ونحن بحاجة إلى فتح باب التحقيق فيها، «فالناس في هذا صنفان، وفي إثباته ونفيه فريقان: صنف يقول: دفنهم أهلُ الغاضرية، وسكت ولم يصرّح بانفرادهم أنّهم استقلّوا بدفنهم، ولم يصرّح بالنفي لاشتراك أحد معهم. الصنف الثاني: يثبت حضور زين العابدين في ذلك الوقت، وهو الذي تولّى مواراة الشهداء ودفنهم، وبيده أنزل أباه الحسين عليه السلام إلى ضريحه المقدّس»([70]).
والمُلفت للنظر أنّ كبار مؤرِّخي الشيعة، كالمفيد وابن طاووس وابن نما الحلّي والطريحي والشهرستاني والأمين وغيرهم، هم ممّن يدخلون تحت الصنف الأول، الذي سكت ولم يصرِّح في هذه المسألة بنفيٍ ولا إثبات، ولم يبد رأياً واضحاً فيها.
ولكن يمكننا أن ندّعي أنّ المنفّذ للتخطيط الإلهي لعمليّة مواراة أجساد شهداء كربلاء هو الإمام زين العابدين عليه السلام، والذي كان في حضوره أيضاً نوع من الإعجاز الغيبي؛ لأنّه كان سجيناً في الكوفة عند ابن زياد.
يوجد في أيدينا دليلان على دعوى حضور الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء، ومباشرته مراسم الدفن، أحدهما: عقائدي كلامي، والآخر: تاريخي روائي.
إنّنا حتى لو قطعنا النظر عن الروايات التي تصرِّح بحضور الإمام زين العابدين عليه السلام، والتي سنشير إلى بعضها في الدليل التاريخي، فإنّه يكفينا دليلاً على ذلك هو القاعدة العقائدية التي تقول: (المعصوم لا يلي أمره إلاّ معصوم)، ومعنى ذلك أنّ المعصوم سواء كان نبياً أو وصياً لا يتولّى شؤونه من تغسيل وتحنيط وتكفين وصلاة ودفن إلاّ معصوم مثله.
وهذه القاعدة من القواعد العقائدية الثابتة والمتّفق عليها بين الإمامية؛ ومن هنا وجدنا أنّ بعض العلماء يجعل تولّي الشؤون المذكورة دليلاً على إمامة المتولّي لها.
يقول الشيخ جواد التبريزي وهو يتحدَّث عن الأدلّة غير المباشرة في إثبات الإمامة: «...فإنّ بعض الروايات تعتمد على ذكر أمرٍ، ذلك الأمرُ يلازم كونه إماماً، كما سيأتي في وصية الإمام الباقر لابنه الصادق عليهما السلام أن يغسِّله ويجهِّزه ويكفّنه، فإنّ هذا من النصّ عليه؛ لما ثبت عندنا من النصوص والإجماع على أنّ الإمام لا يتولَّى تجهيزه إلاّ إمام مثله عند حضوره»([71]).
فهو يرى أنّ وصية الإمام إلى أحد أبنائه بتغسيله وتجهيزه وتكفينه تعتبر نصّاً على إمامة ذلك الابن، وهذا لا يكشف عن ثبوت تلك القاعدة فحسب، وإنّما يكشف عن كونها من العقائد الواضحة والمسلَّم بها في الذهن الشيعي.
يقول الشيخ عبد الواحد المظفر في كتابه بطل العلقمي مستدلاً على إثبات حضور الإمام زين العابدين عليه السلام: «وهذا هو الأوفق بمنهج مذهب الجعفرية وأصول قواعد الإمامية، بل هذه العقيدة أصل من أصول مذهب الاثني عشرية من أنّ المعصوم لا يتولّى أمره إلاّ المعصوم، وقد دلّت عليه الأحاديث الصحيحة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام واحتجّوا به على مخالفيهم، وأصل ذلك توصية النبي صلى الله عليه وآله أن لا يغسّله غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمر أمير المؤمنين عليّ عليه السلام للفضل بن العباس بن عبد المطلب لما دعاه على معاونته على تجهيز النبي صلى الله عليه وآله أن يعصب عينيه معللاً ذلك بأنّه لا يرى أحد جسد النبي صلى الله عليه وآله إلاّ طُمست عيناه»([72]).
وقد عقد الكليني في الكافي باباً مستقلاً بعنوان (باب أنّ الإمام لا يغسّله إلاّ إمام من الأئمة عليهم السلام)([73])، وأورد فيه العديد من تلك الأحاديث، كما يمكن مراجعة تلك الأحاديث في البحار في باب (أنّ الإمام لا يغسّله ولا يدفنه إلاّ إمام)([74]).
وبما أنّنا رجّحنا فيما سبق أنّ الدفن قد حصل في اليوم الثالث عشر من المحرّم، وبما أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام كان في ذلك اليوم مسجوناً في الكوفة؛ إذاً لا بدّ أن يكون حضوره إلى كربلاء حضوراً إعجازياً.
وقد مرّ علينا قول السيد المقرَّم: «وفي اليوم الثالث عشر من المحرّم أقبل زين العابدين عليه السلام لدفن أبيه الشهيد عليه السلام لأنّ الإمام لايلي أمره إلاّ إمام مثله»([75]).
وهذه النتيجة هي النتيجة المنطقيّة التي سيصل إليها كلّ مفكر شيعي يعتقد بصحّة وسلامة الأُمور التي اُستنتجت منها.
يواجه الباحث في المسألة شحّة في الروايات والأخبار التاريخية الدالّة على قيام الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام بدفن أبيه وأهل بيته وأصحابه بعد استشهادهم في كربلاء، فإنّ كتب التاريخ المتقدِّمة ساكتة عن هذه القضية، ومع ذلك فإنّ خبرين يمكن أن يتمسّك بهما كقرينة على المدّعى:
نقل الكشي مناظرة جرت بين الإمام الرضا عليه السلام وبين زعماء الواقفة تفيد أنّ قضية حضور الإمام السجاد عليه السلام عمليةَ الدفن كانت شائعة ومسلَّماً بها بين رواة الحديث من الشيعة بحيث أنّ الإمام الرضا عليه السلام، احتجّ بها على الواقفة.
فقد روى الكشي: «عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن حمدان بن سليمان، عن منصور بن العباس البغدادي، عن إسماعيل بن سهل قال: حدَّثنا بعض أصحابنا، وسألني أن أكتم اسمه، قال: كنت عند الرضا عليه السلام، فدخل عليه علي بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري، فقال له ابن أبي حمزة : ما فعل أبوك؟ قال: مضى. قال: مضى موتاً؟ قال: فقال: نعم. قال: فقال: إلى من عهد؟ قال: إلي. قال: فأنت إمام مفترض الطاعة من الله؟ قال: نعم. قال ابن السراج وابن المكاري: قد والله، أمكنك من نفسه. قال عليه السلام: ويلك وبما أمكنت؟! أتريد أن آتي بغداد وأقول لهارون: إنّي إمام مفترض طاعتي؟! والله، ما ذاك علي، وإنّما قلت ذلك لكم عندما بلغني من اختلاف كلمتكم، وتشتت أمركم؛ لئلاّ يصير سرّكم في يد عدوكم. قال له ابن أبي حمزة : لقد أظهرت شيئاً ما كان يظهره أحد من آبائك ولا يتكلَّم به. قال: بلى والله، لقد تكلَّم به خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين، جمع من أهل بيته أربعين رجلاً، وقال لهم: إنّي رسول الله إليكم. فكان أشدّهم تكذيباً وتأليباً عليه عمّه أبو لهب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: إن خدشني خدشٌ فلست بنبي، فهذا أول ما أبدع لكم من آية النبوة، وأنا أقول: إن خدشني هارون خدشاً فلست بإمام، فهذا أول ما أبدع لكم من آية الإمامة. قال له علي: إنّا روينا عن آبائك عليهم السلام أنّ الإمام لا يلي أمره إلاّ إمام مثله، فقال له أبو الحسن: فاخبرني عن الحسين بن علي عليهما السلام كان إماماً أو كان غير إمام؟ قال: كان إماماً. قال: فمَن ولي أمره؟ قال علي بن الحسين، قال: وأين كان علي بن الحسين؟ قال: كان محبوساً في يد عبيد الله بن زياد! قال: خرج وهم كانوا لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثمّ انصرف. فقال له أبو الحسن عليه السلام: إنّ هذا أمكن علي بن الحسين عليهما السلام أن يأتي كربلاء فيلي أمر أبيه؛ فهو يمكن صاحب الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه، ثمّ ينصرف وليس في حبس ولا في أسار...»([76]).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على ما ادّعيناه من أنّ حضور الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء وقت الدفن كان أمراً شائعاً ومسلَّماً به عند رواة الحديث من الشيعة بما فيهم الواقفة.
لعل من أكثر الأخبار التي فصّلت في مسألة حضور الأمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء وتوليه مراسم الدفن مع بني أسد هو الخبر الذي أورده الدربندي في أسرار الشهادة؛ إذ قال: «وكان إلى جنب العلقمي حيّ من بني أسد، فمشت نساء ذلك الحيّ إلى المعركة فرأين جثث أولاد الرسول، وأفلاذ حشاشة الزهراء البتول، وأولاد علي أمير المؤمنين عليه السلام فحل الفحول، وجثث أولادهم في تلك الأصحار وهاتيك القفار، تشخب الدماء من جراحاتهم كأنّهم قُتلوا في تلك الساعة! فتداخل النساءَ من ذلك المقام العَجَبُ، فابتدرن إلى حيِّهن، وقلن لأزواجهن ما شاهدنه، ثمّ قلن لهم: بماذا تعتذرون من رسول اللّه وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين إذا أُوردتم عليهم حيث إنّكم لم تنصروا أولاده ولا دافعتم عنهم بضربة سيف ولا بطعنة رمح ولا بحذفة سهم؟! فقالوا لهن: إنّا نخاف من بني أُميّة! وقد لحقتهم الذلّة وشملتهم الندامة من حيث لا تنفعهم.
وبقيت النسوة يجلن حولهم ويقلن لهم: إن فاتتكم نصرة تلك العصابة النبويّة، والذبّ عن هاتيك الشنشنة العليّة العلوية، فقوموا الآن إلى أجسادهم الزكية فواروها، فإنّ اللعين ابن سعد قد وارى أجساد مَن أراد مواراته من قومه، فبادروا إلى مواراة أجساد آل رسول الله عليه السلام، وارفعوا عنكم بذلك العار! فماذا تقولون إذا قالت العرب لكم: إنّكم لم تنصروا ابن بنت نبيّكم مع قربه وحلوله بناديكم؟! فقوموا واغسلوا بعض الدرن عنكم! قالوا: نفعل ذلك. فأتوا إلى المعركة، وصارت همّتهم أولاً أن يواروا جثة الحسين عليه السلام ثمّ الباقين، فجعلوا ينظرون الجثث في المعركة، فلم يعرفوا جثّة الحسين عليه السلام من بين تلك الجثث؛ لأنّها بلا رؤوس وقد غيّرتها الشموس، فبينا هم كذلك وإذا بفارس أقبل إليهم حتّى إذا قاربهم، قال: ما بالكم؟ قالوا: إنا أتينا لنواري جثّة الحسين عليه السلام وجثث وِلْده وأنصاره، ولم نعرف جثّة الحسين عليه السلام.
فلما سمع ذلك حنّ وأنَّ وجعل ينادي: وا أبتاه، وا أبا عبد الله، ليتك حاضر وتراني أسيراً ذليلاً. ثمّ قال لهم: أنا أرشدكم. فنزل عن جواده، وجعل يتخطّى القتلى، فوقع نظره على جسد الحسين عليه السلام فاحتضنه وهو يبكي ويقول: يا أبتاه، بقتلك قرّت عيون الشامتين، يا أبتاه، بقتلك فرحت بنو أُميّة، يا أبتاه، بعدك طال حزننا، يا أبتاه، بعدك طال كربنا.
قال: ثمّ إنّه مشى قريباً من محل جثته فأهال يسيراً من التراب، فبان قبر محفور ولحد مشقوق، فأنزل الجثة الشريفة وواراها في ذلك المرقد الشريف كما هو الآن. قال: ثمّ إنّه عليه السلام جعل يقول: هذا فلان، وهذا فلان، هذا والأسديون يوارونهم، فلما فرغ مشى إلى جثّة العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام فانحنى عليها وجعل ينتحب ويقول: يا عمّاه، ليتك تنظر حال الحرم والبنات وهن ينادين: واعطشاه، واغربتاه، ثمّ أمر بحفر لحده وواراه هناك.
ثم عطف على جثث الأنصار وحفر حفيرة واحدة وواراهم فيها، إلاّ حبيب بن مظاهر حيث أبى بعض بني عمّه ذلك، ودفنه ناحية عن الشهداء، قال فلمّا فرغ الأسديون من مواراتهم، قال لهم: هلمّوا لِنواري جثّة الحرّ الرياحي.
قال: فتمشّى وهم خلفه حتى وقف عليه، فقال: أما أنت فقد قبل اللّه توبتك وزاد في سعادتك ببذلك نفسك أمام ابن رسول اللّه عليه السلام.
قال وأراد الأسديون حمله إلى محل الشهداء فقال: لا، بل في مكانه واروه. قال: فلما فرغوا من مواراته ركب ذلك الفارس جواده، فتعلّق به الأسديون، فقالوا بحقّ مَن واريته بيدك مَن أنت؟ فقال: أنا حجّة اللّه عليكم، أنا علي بن الحسين عليه السلام، جئت لأواري جثّة أبي ومَن معه من إخواني وأعمامي وأولاد عمومتي وأنصارهم الذين بذلوا مهجهم دونه، وأنا الآن راجع إلى سجن ابن زياد لعنه اللّه، وأمّا أنتم فهنيئاً لكم، لا تجزعوا أن تضاموا فينا. فودّعهم وانصرف عنهم، وأمّا الأسديون فإنّهم رجعوا مع نسائهم إلى حيِّهم»([77]).
هذه الرواية نقلها الدربندي، عن بعض الثقات، عن كتاب مدينة العلم للسيد نعمة الله الجزائري (ت1112هـ)، ولعله المصدر الوحيد لهذه الرواية؛ إذ لا يوجد فيما نحيط به من المصادر مَن تعرَّض إلى تفاصيل حكاية حضور زين العابدين عليه السلام سوى هذا المصدر.
نعم هناك مصدر آخر تعرَّض إلى ذلك، وهو كتاب الدمعة الساكبة حيث أورد مؤلفه محمد باقر البهبهاني (ت1285هـ ) تفاصيل هذه الحادثة([78])، ولكنّه صرّح بأنّ المصدر الذي نقل عنه هذه التفاصيل هو كتاب أسرار الشهادة، وصرّح أيضاً بأنّه لم ينقل ما قاله عن كتاب أسرار الشهادة بشكل مباشر، وإنّما نقله عن بعض الكتب المعتبرة الناقلة عن أسرار الشهادة، ولم يسمِ لنا هذا الكتاب.
وحينما نقارن بين ما أورده البهبهاني وما أورده الدربندي، لا نجد وفاقاً بينهما في الكثير من التفاصيل؛ ومن هنا احتمل بعض الباحثين أنّ أسرار الشهادة الذي ينقل عنه صاحب الدمعة الساكبة غير أسرار الشهادة للدربندي([79]).
وممّا يؤيد هذا الاحتمال وجود العديد من الكتب بهذا العنوان سوى كتاب أسرار الشهادة للدربندي([80])، وهذه الكتب هي:
1 ـ أسرار الشهادة، وهو اسم لديوان المراثي الفارسي، للأديب الشاعر ميرزا إسماعيل الملقب بسرباز.
2 ـ أسرار الشهادة فارسي كبير، للمولى محمد حمزة المعروف بشريعتمدار الحمزة كلائى البار فروشي.
3 ـ أسرار الشهادة فارسي مختصر، للسيد ميرزا رفيع الدين نظام العلماء بن ميرزا علي أصغر بن ميرزا رفع الطباطبائي التبريزي (ت 1326هـ).
4ـ أسرار الشهادة للسيد كاظم بن قاسم الرشتي الحائري (ت1259هـ)، فيه بيان أسرار قضية الطفّ، كتَبه إجابة لالتماس الحاجّ المولى عبد الوهاب القزويني.
5ـ أسرار الشهادة فارسي، للمولى محمد بن محمد مهدي المازندراني البار فروشي، الشهير بالحاجّ الأشرفي (ت 1315 هـ ).
6ـ أسرار الشهادة للسيد محمد مهدي بن محمد جعفر الموسوي التنكابني.
ولكنّ التحقيق في طبيعة هذه الكتب وفي تواريخ تأليفها يوهن من قوّة هذا التأييد، ويبقي الإشكال قائماً على حاله، فبعض هذه الكتب نجهل طبيعة الموضوع الذي تتناوله، وبعضها لا علاقة له بالتاريخ وإنّما هو كتاب أدب وشعر، والبعض الآخر قد كُتب بعد وفاة البهبهاني بعقود.
وأياً كان، فإنّ الرواية التي تشرح كيفيّة حضور الإمام زين العابدين عليه السلام وإن لم يكن لها أثر في مصادر الطفّ القديمة إلاّ أنّها موافقة لما عليه اعتقاد الطائفة من (أنّ المعصوم لا يلي أمره إلاّ معصوم مثله).
ومن هنا وجدنا السيد المقرَّم يقول: «وفي اليوم الثالث عشر من المحرّم أقبل زين العابدين عليه السلام لدفن أبيه الشهيد عليه السلام، لأنّ الإمام لايلي أمره إلاّ إمام مثله»([81]).
فقد جعل هذه القاعدة الأساس في إثبات حضور الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء وقت الدفن، ثمّ أورد بعد ذلك تفاصيل الحكاية.
إعراض مصادر الطفّ المعتبرة عن هذه الروايات
بقي إشكال مهم لا بدّ من معالجته قبل أن نختم الحديث في هذا المبحث، والإشكال هو ما أشرنا إليه سابقاً من خلو مصادر الطفّ المعتبرة ـ لاسيما القديم منها ـ من الروايات التي تثبت حضور الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء ومواراته لأجساد الشهداء.
وفي الحقيقة يجب الاعتراف بأنّ الإشكال في غاية القوّة ولا يمكن غضّ النظر عنه، وما يختلج في البال من الجواب على ذلك يتمثّل بثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول: عدم اطّلاع المتقدِّمين على هذه الروايات
إنّ عدم وجود هذه الروايات في المصادر القديمة ووجودها في المصادر المتأخرة لا يعني بالضرورة أنّ هذه الروايات لم تكن موجودة في العصور المتقدِّمة، فقد تكون لأصحاب الكتب المتأخرة مصادرهم التي لم يطّلع عليها المتقدِّمون.
يقول الشيخ محمد السند: «... وفي علم التاريخ والرواية التاريخيّة كلّما كان المصدر أقدم كان أثبت وأقوى، لا بمعنى أنّ الكتاب التاريخي الذي كُتب في القرن التاسع لا يُعتمد عليه، أو ما كُتب في القرن الثالث عشر لا يعتمد، بل يبقى مصدراً تاريخيّاً، غاية الأمر أنّ المصادر التاريخية كلّما كانت أقدم كانت أثبت»([82]).
وتوفّر مصادرٍ لأصحاب الكتب المتأخرة لم يطّلع عليها المتقدمون، ليس مجرد فرضية، بل هذا ما وقع فعلاً لعدد منهم، لا سيما في فترة الحكم الصفوي الذي كان مسانداً للمدّ الأخباري، فقد تتبعت المدرسة الأخبارية أمر المندثر من كتب الحديث، وضاعفت البحث عنه، فعثرت على نتاج كبير وقع جدلٌ في صحّة الاعتماد عليه، فقد عثر النوري (ت1320هـ) ـ مثلاً ـ على (كتاب الجعفريات أو الأشعثيات) واعتبره أحد الأُصول الأربعمائة عند الشيعة، والذي كان العثور عليه أقوى دافع للنوري على تصنيف (كتاب مستدرك الوسائل)، كما عُثر على نسخة عتيقة من كتاب المزار.
وعثر المجلسي (ت 1111 هـ) على ما أعتبره أنّه (كتاب الفقه الرضوي) وهكذا ساعدت الموقعية التي كان يتمتع بها المجلسي، مالياً وسياسياً واجتماعياً في الدولة الصفوية، وتمركزه في عاصمتها آنذاك أصفهان، على بثّ عدد كبير من تلامذته في البحث عن تراثٍ حديثي أو نتاج شيعي تراثي قديم([83]).
يقول المجلسي في مقدِّمة بحار الأنوار: «...ثمّ بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعتُ الأُصول المعتبرة المهجورة، التي تُركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية، إمّا لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلالة، أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهّال المدّعين للفضل والكمال، أو لقلّة اعتناء جماعة من المتأخرين بها، اكتفاءً بما اشتهر منها؛ لكونها أجمع وأكفى وأكمل وأشفى من كلّ واحد منها، فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حيناً، وألحّ في الطلب لدى كلّ مَن أظنّ عنده شيئاً من ذلك وإن كان به ضنيناً، ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان، ضربوا في البلاد لتحصيلها، وطلبوها في الأصقاع والأقطار طلباً حثيثاً، حتى اجتمع عندي بفضل ربي كثير من الأُصول المعتبرة، التي كان عليها معوَّل العلماء في الأعصار الماضية، وإليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية، فألفيتها مشتملة على فوائد جمّة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة...»([84]).
والخلاصة: إنّنا نحتمل أنّ أصحاب هذه المصادر لم يتسنَّ لهم الاطّلاع على هذه الروايات؛ ولذلك لم ينقلوها في كتبهم.
الاحتمال الثاني: اطّلعوا عليها ولم ينقلوها
يُحتمل أنّ هؤلاء المؤرِّخين قد اطّلعوا على هذه الروايات ولكنّهم لم يعتمدوها؛ وبالتالي لم ينقلوها في كتبهم، وخصوصاً إذا التفتنا إلى أنّ المؤرِّخين المشار إليهم كلّهم من الفقهاء، وربما يكونون قد تعاملوا مع روايات الطفّ من خلال المنهج العقائدي أو المنهج الفقهي في قبول أو ردّ الرواية، وليس من خلال المنهج التاريخي، ومن المعلوم أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين هذه المناهج.
فقد تكون الرواية ساقطة بحسب الموازين الفقهية ولكنّها مقبولة بحسب الموازين التاريخية، وقد تكون الرواية مقبولة بحسب الموازين الفقهية ولكنّها ساقطة بحسب الموازين العقائدية.
يقول الشيخ محمد السند: «نرى بعضاً من الباحثين والمحققين يتشدّد في قصّ الرواية عن واقعة كربلاء والبحث عنها، مثلما يتشدد في الرواية التي يعتمد عليها في استنباط الحكم الفقهي؛ فلذا يتعامل مع رواية الواقعة بدقّة علمية بالغة، ويؤكد على ضرورة أن تكون الرواية مسندة وصحيحة، وإنّها لا بدّ أن تكون من كتاب معتبَر، وغير ذلك من الضوابط والشروط. وبعضاً آخر يتشدّد أكثر من ذلك، حيث إنّ واقعة كربلاء بتفاصيلها وجزئياتها والعِبَر التي فيها هي قضايا عقائدية، فينبغي ـ في رأيه ـ التشدّد أكثر، وسبر الرواية فيها بدرجة أشدّ، وربما ترى البعض يمارس الرواية القصصية في هذا المجال، وقد يكون سرد الواقعة يأخذ طابع الرواية القصصية، كما يصدر هذا النوع غالباً من القائمين على إحياء الشعائر مباشرة.. هناك مَن يعرضها على غرار الرواية التاريخية المطلقة»([85]).
الاحتمال الثالث: عدم نقل المتقدّمين للروايات تقيةً
يمكن أن تكون هذه الروايات موجودة وقد اطّلع عليها المتقدِّمون وتناقلوها شفاهاً، كما أنّها قد تكون قوية السند حتى على ضوء المنهج الفقهي المتشدّد، ومع ذلك لم يدوّنوها في كتبهم؛ وذلك لتعارضها مع التقيّة، لأنّ إثبات حضور الإمام السجاد عليه السلام لتولّي أمر أبيه يعني أنّه هو الإمام المعصوم المفترَض الطاعة بعد أبيه.
والموروث الروائي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام لم يُدوّن بأجمعه في كتب المتقدِّمين، وإنّما كانوا يدوّنون ما لا يتعارض مع التقيّة، أمّا ما يكون معارضاً لها فكانوا يحافظون عليه من خلال النقل الشفهي، كما كان عليه الحال في عصر ما قبل تدوين السنّة.
وعندما ارتفعت التقيّة في العصور المتأخرة وقويت شوكة الشيعة، أخذ بعض المتأخرين بتدوين هذه الروايات وإدراجها في الأبواب المناسبة لها.
كيفية الدفن وتعيين قبور الشهداء
قبل الدخول في كيفيّة الدفن، وتحديد وتشخيص قبر الإمام الحسين عليه السلام وسائر قبور الشهداء بحسب ما دلّت عليه المصادر التاريخية، أودّ أن ألفت الانتباه إلى أنّنا بعد أن أثبتنا فيما سبق أنّ الكيفيّة التي تمّ دفن الشهداء بها كانت بتخطيط السماء وتنفيذها، فبنفس هذا الدليل يمكننا ـ أيضاً ـ إثبات أنّ ما عليه العمل اليوم من تعيينٍ لقبور الشهداء هو الصحيح، وافق بعض الروايات أو لم يوافقها؛ وذلك لأنّ اليد الإلهية التي خططت ونفّذت لعملية دفن الشهـداء ـ بالكيفيّة التي أرادتها ـ هي الكفيلة بأن تحافظ على هذه الكيفيّة إلى آخر الدهر.
فرغم المحاولات الرامية إلى طمس القبر المقدّس ومحو معالمه من قِبَل طغاة بني العباس([86])، إلاّ أنّ إرادة الله سبحانه وتعالى قد حالت بينهم وبين ما يشتهون؛ ليبقى هذا القبر الطاهر مفزعاً وملاذاً للمؤمنين إلى يوم القيامة.
وهذا ما استشفّته السيدة زينب عليها السلام من وراء الغيب، حيث جاء في حديثها مع ابن أخيها الإمام السجاد عليه السلام: «... ولقد أخذ الله ميثاق أُناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات، إنّهم يجمعون هذه الأعضاء المقطّعة والجسوم المضرّجة فيوارونها، وينصبون بهذا الطفّ علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يُدرس أثره ولا يُمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدنَّ أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا علواً ...» ([87] ).
تعيين قبور الشهداء بحسب الأدلة التاريخية:
من المعروف لكل مَن تشرَّف بزيارة كربلاء المقدّسة أنّه يوجد في داخل الحائر الحسيني المقدّس أربعةُ أضرحة منفصلة عن بعضها البعض:
1ـ ضريح الإمام الحسين عليه السلام:
هو ضريح سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام يقع تحت القبّة المنوّرة مباشرة، ونسبة هذا القبر الشريف إلى صاحبه ممّا لا ريب فيها عند جميع المؤرِّخين بلا خلاف، ومن القطعيّات التاريخية التي لا يرتقي إليها الشك.
2ـ ضريح علي بن الحسين عليهما السلام:
يقع ضريح علي الأكبر عليه السلام مما يلي رجلي الإمام الحسين عليه السلام، أي من جهة الشرق، وضريحه مجاور لضريح الحسين عليه السلام، ويحيط بهما شباك واحد، وهذا هو السبب في تكوّن الشباك من ستّة أضلاع.
ونسبة هذا القبر إلى علي الأكبر عليه السلام ثابتة أيضاً، ولم يخالف في ذلك أحد ممّن تعرّض إلى كيفيّة الدفن من المؤرِّخين، كالمفيد والطريحي والدربندي والحائري والأمين والمقرَّم وغيرهم.
على أنّه يمكن استفادة هذا الأمر ـ أيضاً ـ من بعض زيارات الإمام الحسين عليه السلام، فمِن ذلك ـ مثلاً ـ ما جاء في الزيارة التي رواها ابن قوليه في كامل الزيارات عن أبي حمزة الثمالي، عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال له عليه السلام بعد أن انتهى من بيان كيفيّة زيارة الإمام الحسين عليه السلام: «ثمّ صر إلى قبر علي بن الحسين عليهما السلام، فهو عند رجلي الحسين بن علي عليهما السلام ...»([88]).
3ـ ضريح الشهداء (بني هاشم والأنصار):
ضريح الشهداء هو عبارة عن قبر جماعي يقع ممّا يلي رجلي الإمام الحسين عليه السلام، ويفصل بينه وبين مرقد الحسين عليه السلام مرقد علي الأكبر عليه السلام، وهو يرمز إلى الشهداء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، ويشمل جميع الشهداء ـ من هاشميين وغيرهم ـ ما عدا مَن استثنينا ومَن سنستثني.
وهذا هو الموافق للمقدار المتيقّن من مجموع النصوص الواردة في هذا المجال، حيث إنّنا من خلال التأمّل في هذه النصوص نجد أنّ هناك أربعة أُمور يمكن القطع بها، وهي:
أولاً: إنّ دفن الشهداء من الهاشميين والأصحاب قد تمّ بشكل جماعي.
ثانياً: إنّهم دُفنوا جميعاً ممّا يلي رجلي الحسين عليه السلام.
ثالثاً: إنّ الحائر محيط بهم، كما قال الشيخ المفيد.
رابعاً: إنّه لا توجد لهم أجداث على الحقيقة؛ ولذا جاء في جميع زياراتهم، أنّ الزائر يزورهم من عند رجلي الإمام الحسين عليه السلام مشيراً إلى الأرض.
قال السيد الأمين في المجالس السَّنيّة: «... ولذلك يمتنع أهل المعرفة من المرور من جهة رجلَي الحسين عليه السلام خوفاً من المشي فوق قبورهم الشريفة»([89]).
فهذا هو المقدار المتيقّن والمقطوع به في كيفيّة دفن الشهداء، أمّا التفاصيل، فقد اختلفوا واضطربت كلماتُهم فيها.
الأقوال في كيفيّة دفن الشهداء بشكل جماعي:
المتحصَّل لدينا بعد ملاحظة جميع كلماتهم ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنّهم حُفرت لهم حفيرة كبيرة و أُلقوا فيها جميعاً ـ يعني الهاشميين والأصحاب ـ وسُوِّي عليهم التراب. وهذا هو قول الشيخ المفيد في موضع من الإرشاد، والطبرسي في إعلام الورى، والدربندي في أسرار الشهادة، وغيرهم.
قال الشيخ المفيد: «... وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه ـ الذين صُرعوا حوله ـ مما يلي رجلي الحسين عليه السلام وجمعوهم، فدفنوهم جميعاً معاً...»([90]).
ومثله قال الطبرسي في إعلام الورى([91])، وقد نقلنا سابقاً قول صاحب أسرار الشهادة فلا داعي لإعادته.
القول الثاني: إنّ الهاشميين قد دُفنوا في حفيرة واحدة مما يلي رجلي الحسين عليه السلام، وأمّا الأصحاب فقد دفنوا في قبور جماعية متعدّدة حول الحسين عليه السلام.
وهذا القول هو قول الطريحي في المنتخب([92])، وقبل ذلك هو قول المفيد في موضع آخر من الإرشاد؛ ولذا صرَّح الكثير من الباحثين أنّ كلام المفيد مضطرب في هذا الموضوع ومتناقض، فقد جاء في الفصل الذي عقده لتعداد أسماء مَن قُتل مع الحسين عليه السلام من أهل بيته بطفّ كربلاء: «وهم كلّهم مدفونون ـ يعني الهاشميين ـ مما يلي رجلي الحسين عليه السلام في مشهده، حفر لهم حفيرة وأُلقوا فيها جميعاً وسُوّي عليهم التراب».
ثمّ قال: «فأمّا أصحاب الحسين رحمة الله عليهم الذين قُتلوا معه، فإنّهم دُفنوا حوله، ولسنا نحصل لهم أجداثاً على التحقيق والتفصيل، إلاّ أنّا لا نشك أنّ الحائر محيط بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسكنهم جنات النعيم»([93]).
فهذا النصّ يعارض النصَّ الأول ويخالفه في الدلالة، كما فطن إلى ذلك كثير من الباحثين: «حيث إنّ النصّ الأول صريح في أنّ جميع الشهداء ـ من هاشميين وغير هاشميين ـ دفُنوا في قبر جماعي واحد. ويبدو من النصّ الثاني أنّ الهاشميين دُفنوا وحدهم في قبر واحد، وغير الهاشميين من الشهداء دفنوا ـ كما يوحي به النصّ ـ في قبور جماعية متعدّدة حول الحسين عليه السلام»([94]).
القول الثالث: إنّهم حُفرت لهم حفيرتان: واحدة للهاشميين مما يلي رجلي الحسين عليه السلام، والثانية للأصحاب خلف حفرتهم.
قال الشيخ عبد الواحد المظفر: «تصرِّح الأحاديث أنّ الشهداء حُفرت لهم حفيرتان: واحدة للعلويين ممّا يلي رجلي الحسين عليه السلام، والثانية لأنصارهم خلف حفيرتهم»([95]).
ولا ندري أين هي تلك الأحاديث التي صرَّحت بهذا المعنى الذي ذكره المظفر؟! فليته أوقفنا على تلك الأحاديث، أو على الأقلّ أشار إلى مصادرها في الهامش لكي نتتبعها!
نعم ذكر السيد عبد الرزاق المقرّم ـ عند تعرِّضه إلى حادثة حضور الإمام زين العابدين عليه السلام إلى طفّ كربلاء لمواراة الأجساد الطاهرة ـ أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام «...ترك مساغاً لبني أسد بمشاركته في مواراة الشهداء، وعيَّن لهم موضعين، وأمرهم أن يحفروا حفرتين، ووضع في الأُولى بني هاشم، وفي الثانية الأصحاب...»([96]).
ولعل هذه الرواية الوحيدة التي بُني عليها هذا القول بحسب تتبعي للمصادر.
القول المختار في تعيين قبور الشهداء:
لا يوجد لدينا ما يُركن إليه في القطع بأحد هذه الأقوال الثلاثة، ولكنّنا نميل إلى القول الأول، وهذا الميل يوجبه التأمّل والتمعّن في الروايات التي تشرح كيفية زيارة الشهداء، فجميع تلك الروايات تأمر الزائر بأن يقف عند رجلي الحسين عليه السلام بعد أن يكون قد فرغ من زيارة علي الأكبر عليه السلام، يشير إلى الشهداء جميعاً من الهاشميين والأصحاب، ويزورهم زيارة جماعية واحدة.
فلو صحّ فصل الهاشميين عن الأصحاب بالكيفيّة التي ادّعاها أصحاب القول الثاني، أو التي ادّعاها أصحاب القول الثالث، لكان هذا الفصل لخصوصية تميّز إحدى المجموعتين عن الأُخرى، وهذا يستوجب أن يُفرد لكلّ منهما زيارة خاصّة، مع أنّ هذا لم يرد. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اعتراض الشيخ المظفر على الدفن الجماعي للشهداء:
حاول الشيخ عبد الواحد المظفر في كتابه بطل العلقمي أن يقرأ حادثة دفن الأجساد قراءة فقهية، وبعبارة أخرى أنّه حاول أن يرسم ويصوّر لنا كيفيّة ما جرى، معتمداً على المعطيات والمؤشرات التاريخيّة من جانب، وعلى ما في مخزونه من مسبقات وخلفيات فقهية من جانب آخر، فأظهر لنا صورة عن كيفيّة دفن الأجساد تختلف ـ من حيث التفاصيل ـ عن كلّ الصور التي رسمها لنا المؤرِّخون، وإن كانت تتفق معها من حيث الإجمال.
ونحن من حيث المبدأ لسنا ضد تأويل النصّ بمعنى فهمه على ضوء المسبقات والخلفيات التي يحملها القارئ، بل إنّنا نؤمن بأزيد من هذا، وهو أنّ عملية التأويل بهذا المعنى ليست اختيارية، بل هي ملازمة لكلّ قراءة إذا لم تكن هي عين عمليّة القراءة، إلاّ أنّنا نعتقد أنّ هذه العمليّة يجب أن تتمّ وفق شروط وضوابط لكي لا نحمِّل النصّ ما لا يحتمله، وتفصيل ذلك ليس هنا محله.
قال الشيخ عبد الواحد المظفر: «لا ريب أنّ أقلّ ما روي في شهداء بني هاشم ثمانية عشر إنساناً، وفي الأنصار سبعين، هذا هو المتيقّن؛ لأنّه أقلّ الأقوال ويتفسّح في جانب الكثرة. فإذا قلنا إنّ الدفن هو الشرعي لا أنّهم جمعوهم جمع الحاجيات في المستودعات، فلا بدّ أن يشقّ لكلّ واحد في الحفيرة ضريح لا يقل عرضه عن متر واحد، فإذا قِسْتَ ثمانية عشر متراً من رجلي الحسين عليه السلام إلى الرواق الشرقي استوعبت قبورُ الهاشميين الرواقَ الشرقي كلّه، وربما أخذت من الصحن شيئاً؛ إذ مسافة الساحة من رجلي الحسين عليه السلام إلى الرواق الشرقي لا يزيد عن هذا المقدار إن لم تنقص عنه.
وإذا انتقلنا إلى حفرة الشهداء كذلك بجعل الواحد إلى جنب الآخر نحتاج إلى سبعين متراً، مبتدئين بضريح حبيب بن مظاهر إلى سور الصحن الشرقي إن لم ينقص عن هذا المقدار فلا يزيد عليه.
فعندي من هذا الاستنتاج أنّ مساحة مراقد الشهداء أوسع من هذه الدائرة الضيِّقة المحصورة في الرواق الحسيني، ولا يعقل أن يُجزم بها إلاّ على إلغاء الدفن الشرعي وجعلها مستودعات للجثث الواحدة فوق الأخرى، كمستودعات أكياس الحبوب، وهذا ما لا يجوز التفوّه به ومحال أن يفعله الإمام زين العابدين عليه السلام، بل حتى لو اقتصرنا على الأسديين، محال أن يفعلوا ذلك وهم عقلاء مسلمون ...»([97]).
لنا على كلامه عدّة ملاحظات:
الملاحظة الأولى: قوله: «لا ريب أنّ أقلّ ما روي في شهداء بني هاشم ثمانية عشر إنساناً».
يلاحظ عليه أنّ هذا هو أقلّ ما روي في العدد الكلي للشهداء الهاشميين بما فيهم الحسين والعباس وعلي الأكبر عليهم السلام، قال الشيخ المفيد في الإرشاد: «أسماء مَن قُتل مع الحسين بن علي عليهما السلام من أهل بيته بطفّ كربلاء، وهم سبعة عشر نفساً، الحسين بن علي عليه السلام ثامن عشر منهم...»([98]).
أقول: فإذا كان كذلك، فقول المظفر بعد ذلك: «فإذا قِسْتَ ثمانية عشر متراً من رجلي الحسين عليه السلام إلى الرواق الشرقي استوعبت قبورُ الهاشميين الرواقَ الشرقي كلّه» قول غير دقيق حتى بناءً على فكرته؛ لأنّ الشهداء الهاشميين المدفونين ممّا يلي رجلي الحسين عليه السلام ستّة عشر إنساناً، هذا إذا قلنا: إنّ علياً الأكبر في جملتهم، أما إذا قلنا: إنّه مدفون في ضريح منفرد يكون العدد خمسة عشر.
الملاحظة الثانية: قوله: «فإذا قلنا إنّ الدفن هو الشرعي لا أنّهم جمعوهم جمع الحاجيات في المستودعات...».
أقول: إنّنا إذا كنا نعتقد بأنّ الإمام زين العابدين عليه السلام هو مَن تولّى الإشراف على عملية الدفن، ثمّ اعتقدنا بصحّة الروايات التي تحدَّثت عن هذه الكيفيّة الجماعية، فإنّ هذين الأمرين هما اللذان يعطيان الشرعيّة لهذا الدفن، وعندها سنقول: إنّ الدفن الجماعي جائز لما ثبت من أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام قام بفعله؛ وبالتالي فلا معنى للقول بأنّها عملية غير شرعية.
الملاحظة الثالثة: يمكن التنزُّل عمّا قلناه في الملاحظة السابقة، ونقول: إنّ الشيخ المظفر لا يقصد الردّ على الإمام عليه السلام ـ وهذا هو المتوقَّع طبعاً ـ وإنّما يقصد التشكيك بصحّة هذه الروايات، إلاّ أنّ هذا مرفوض أيضاً؛ فإنّه لا يصحّ ردّ الرواية لمجرَّد كونها لا تنسجم مع الذوق الفقهي الشخصي، وقد نقل هذه الروايات كبار فقهاء الطائفة في كتبهم، وفي مقدَّمتهم الشيخ المفيد في الإرشاد، ولم أجد منهم أحداً استشكل ممّا استشكل منه المظفر!
الملاحظة الرابعة: إنّ فقهاءنا لا يفتون بحرمة الدفن الجماعي ابتداءً، وإنّما قالوا بكراهيته؛ لقولهم عليهم السلام: «لا يُدفن في قبر واحد اثنان»([99]). هذا في حال الاختيار، أمّا في حال الاضطرار، فحتى الكراهة تزول، كما لو كَثُر الموتى وعسر الإفراد؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال يوم أحد: «احفروا ووسّعوا وعمّقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وقدِّموا أكثرهم قرآنا»، فدفن شهداء أحد في قبور جماعية ([100]).
ولنختم كلامنا ـ في هذه الجهة من البحث ـ بما جاء في كتاب منهاج البراعة للسيد مير حبيب الله الهاشمي الموسوي الخوئي إذ قال: «قد تقدَّم في شرح هذا الكتاب [أي منهاج البراعة] أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد كانوا يدفنون الاثنين والثلاثة من القتلى في قبر واحد.
وكذلك قد تظافرت الآثار في أنّ ابن سعد لعنة الله عليه لمّا رحل من كربلاء، خرج قوم من بني أسد كانوا نزولاً بالغاضرية إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأصحابه روحي لهم الفداء، فصلّوا عليهم، ودفنوا الحسين عليه السلام حيث قبره الآن، ودفنوا ابنه علي بن الحسين الحسين عليه السلام، وجمعوهم فدفنوهم جميعا معاً، ودفنوا العباس بن علي عليهما السلام في موضعه الذي عند رجله، وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين صُرعوا حوله مما يلي رجلي قُتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن. ففيهما دلالة على جواز دفن ميتين أو أكثر في قبر واحد.
أمّا الأول: فلأنّه كان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان بإذنه حيث قال صلى الله عليه وآله: انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن، فاجعلوه أمام أصحابه في القبر.
وقال في الخبر الآخر ـ المروي عنه صلى الله عليه وآله كما في مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ـ إنّه قال للأنصار يوم أحد: احفروا وأوسعوا وعمّقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد.
وأما الثاني: فلأنّ بني أسد كانوا مسلمين، بل لعلهم كانوا مؤمنين, فلولا علمهم بجواز ذلك من الشرع لما فعلوه في المقام، على أنّه لم ينكر عليهم أحد»([101]).
4ـ ضريح حبيب بن مظاهر الأسدي:
وهو موجود عند رأس الحسين عليه السلام، لا يفصل بينهما إلاّ عدّة أمتار. وهناك أمران أساسيان يدلاّن على صحّة نسبة هذا الضريح إلى حبيب بن مظاهر الأسدي، وهما:
الأمر الأول: وجود بعض النصوص الدالّة على صحّة هذه النسبة، ومنها:
قال صاحب أسرار الشهادة ـ وقد مرّ علينا سابقاً ـ : «...ثمّ عطف ـ يعني الإمام زين العابدين عليه السلامـ على جثث الأنصار وحفر حفيرة واحدة وواراهم فيها، إلاّ حبيب بن مظاهر حيث أبى بعض بني عمّه ذلك، ودفنه ناحية عن الشهداء...»([102]).
وقال السيد الأمين في المجالس السَّنيّة: «... ودفنت بنو أسد حبيب بن مظاهر الأسدي عند رأس الحسين عليه السلام حيث قبره الآن اعتناء بشأنه ...»([103]).
وفي ذخيرة الدارين لعبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الحائري الشيرازي قال: «... وقال أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء: ودفنت بنو أسد حبيباً عند رأس الحسين عليه السلام حيث قبره الآن اعتناء بشأنه، لأنّه منهم ورئيسهم ...»([104]).
الأمر الثاني: هو عمل الشيعة على ذلك وتعاهدِهم لهذا الضريح وعنايتهم به جيلاً بعد جيل وبمرأى ومسمع من فقهاء الطائفة ومراجعها، فإنّ هذا لا يمكن أن يكون بلا مستند!
ولولا هذان الأمران، لكان مقتضى إطلاق النقول السابقة([105]) هو كون حبيب ابن مظاهر مدفوناً في جملة الشهداء.
ونحن لا نستكثر أن يكون لحبيب بن مظاهر مرقد منفرد ومقام مستقلّ؛ وذلك للمنزلة الرفيعة التي كان يتمتّع بها من بين أصحاب الحسين عليه السلام، فقد كان من أصحاب أمير المؤمنين وخواصّه وحمَلَة أسراره، وممّن علَّمه أمير المؤمنين عليه السلام عِلم المنايا والبلايا، أمّا استشهاده بين يدي الحسين عليه السلام، فقد زاده شرفاً إلى شرفه ورفعة إلى رفعته.
قال أبو مِخنَف: «لمّا قُتل حبيب بن مظاهر هدّ ذلك حسيناً، وقال عند ذلك: احتسب نفسي وحماة أصحابي» ([106]).
وفي ذلك قال الشيخ السماوي في إبصار العين:
|
إن يهدّ الحسينَ قتلُ حبيب
|
|
فلقد هدّ قتلُه كلَّ ركن([107])
|
كان حديثنا عن الأضرحة الموجودة داخل الحرم الحسيني المقدّس، وبقي علينا أن نتحدَّث عن ضريحين طاهرين لبطلين من أبطال واقعة الطفّ، يقعان خارج الحائر الحسيني المطهَّر، وهما: ضريح العباس عليه السلام، وضريح الحرّ الرياحي، فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لكلّ واحد من هذين الفذَّين مزار خاصّ وقبّة تُحاكي السماء علّواً وشموخاً.
1 ـ ضريح العباس عليه السلام:
ومكانه أشهر من أن يخفى، فإذا خرجت من الباب الشرقي لصحن سيد الشهداء عليه السلام أشرقت عليك أنوار قبّته الذهبية المنصوبة فوق ضريحه المقدّس، قريباً من نهر العلقمي، فتشعر في هذه الحال أنّك تسير من الإباء إلى الفداء، ومن العزّة إلى الكرامة، ومن الثبات إلى البطولة، ومن الجمال إلى الجلال، ومن الضياء إلى النور، ومن الشمس إلى القمر.
قال الشيخ عبد الواحد المظفر: «فإنّ أبا الفضل بدون ارتياب ولا تشكيك دفن على مسناة العلقمي، وهذا متواتر في النقل، وعليه عمل الشيعة من حين دفنه إلى يومنا هذا»([108]).
ولعل أقدم نصٍّ تاريخي يحدّد لنا قبر العباس عليه السلام هو ما قاله الشيخ المفيد في الإرشاد: «...ودفنوا العباس بن علي عليهما السلام في موضعه الذي قُتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن ...»([109]).
قال السيد المقرَّم بعد نقله لقول الشيخ المفيد السابق: «وعلى هذا مشى العلماء المحققون والمنقّبون في الآثار من كون مشهده بحذاء الحائر الشريف، قريباً من شط الفرات، نصّ عليه الطبرسي في إعلام الورى، والسيد الجزائري في الأنوار النعمانية، والشيخ الطريحي في المنتخب، والسيد الداودي في عمدة الطالب، وحكاه في رياض الأحزان عن كامل السقيفة. وهو الظاهر من ابن إدريس في السرائر، والعلاّمة في المنتهى، والشهيد الأول في الدروس، والأردبيلي في شرح الإرشاد، والسبزواري في الذخيرة، والشيخ آغا رضا في مصباح الفقيه، فإنّهم نقلوا كلام المفيد ساكتين عليه»([110]).
2 ـ ضريح الحرّ الرياحي:
ويقع على مسافة عدّة كيلو مترات من مشهد الحسين عليه السلام، ونسبة هذا المشهد إلى الحرّ مقطوع بصحّتها عند المؤرِّخين والباحثين المهتمّين بهذا الشأن، لا سيما عند المتأخرِّين.
قال السيد المقرَّم: «... فهذا المشهد المعروف له ممّا لا ريب في صحّته؛ للسيرة المستمرة بين الشيعة على زيارته في هذا المكان، وفيهم العلماء والمتديِّنون.
ويظهر من الشهيد الأول المصادقة عليه، فإنّه قال في مزار الدروس: وإذا زار الحسينَ فليزر عليَّ بن الحسين وهو الأكبر على الأصحّ، وليزر الشهداءَ وأخاه العباس والحرّ بن يزيد. ووافقه العلاّمة النوري في اللؤلؤ والمرجان ص115، واعتماد السلطنة محمّد حسن المراغي ـ من رجال العهد الناصري ـ في حجّة السعادة على حجّة الشهادة ص56، طبع تبريز.
وقال المجلسي في مزار البحار عند قوله عليه السلام في زيارة الشهداء العامّة: فإنّ هناك حومة الشهداء، المراد منه معظمهم أو أكثرهم، لخروج العباس والحرّ عنهم...»([111]).
وممّا يوجب القطع بصحّة نسبة هذا المرقد إليه هو ما ظهر منه من الكرامات والبيِّنات، ولعل أشهر تلك الكرامات والبيِّنات ما رواه الجزائري في الأنوار النعمانية، حيث قال: «إنّ الشاه إسماعيل لمّا ملَك بغداد، وزار قبر الحسين عليه السلام، وبلغه طعن بعض العلماء على الحرّ، أمر بنبشه لكشف الحقيقة، ولمّا نبشوه رآه بهيئته لمّا قُتل، ورأى على رأسه عصابة قيل له: إنّها للحسين، فلمّا حلَّها نبع الدم كالميزاب، وكلمّا عالج قطعه بغيرها لم يتمكن، فأعادها إلى محلِّها، وتبيَّنت الحقيقة، فبنى عليه قبّة، وعيَّن له خادماً، وأجرى لها وقفاً»([112]).
نعم اختلف المؤرِّخون في سبب حمل الحرّ ودفنه في هذا المكان، فقال بعضهم: إنّ عشيرته هي التي حملته من مصرعه ودفنته هناك.
وقيل: إنّ أمّه كانت حاضرة، فلمّا رأت ما يصنع بالأجساد حملت الحرّ إلى هذا المكان.
وقد مرّ بنا في النصوص التي اقتبسناها من مدينة العلم وأسرار الشهادة أنّ الإمام السجاد عليه السلام هو الذي دفنه في هذا الموضع، وقد استبعد ذلك السيد المقرَّم، فقال: «فإنّه من البعيد جداً أن تحمله العشيرة، ثمّ تترك عميدها في البيداء عرضة للوحوش، بل لم يُعهد ذلك في أيِّ أمّة وملّة»([113]).
نعم يمكن قبول ذلك إذا أحلنا حمل الحرّ إلى هذا الموضع إلى سبب غيبي مجهول غير ما ذُكر، والله أعلم بحقيقة الحال.
بعد أن عرفنا أنّ عملية دفن شهداء كربلاء بهذه الكيفيّة التي عليها الآن، ـ والتي كانت نتاج تدخُّل السماء وضمن تخطيط إلهي مدروس، على يد إمام معصوم ـ فلسائل أن يسأل عن الحكمة والمغزى من وراء هذه الطريقة في توزيع المراقد الشريفة، وهل هناك رسائل أراد الله سبحانه إيصالها إلينا عِبْرَ هذا الأُسلوب؟ وهل هناك رمزية معيَّنة لهذه العملية من الدفن؟
في هذا المبحث نحاول أن نتلمس إجابات لتلك التساؤلات التي ربما تخطر في بال الكثيرين الذين يقرأون المباحث الأولى لهذا الكتاب، فإتماماً للفائدة أردنا أن يكون المبحث الرابع مخصصاً للحديث عن رمزيّة هذا الأُسلوب في عمليّة مواراة شهداء كربلاء.
إنّ الحديث في هذا المبحث لا يشمل الإمام الحسين عليه السلام، وإنّما الحديث هو عن باقي الشهداء من أهل البيت عليهم السلام والأنصار، الذين كان أُسلوب دفنهم ـ كما بيّنّا ـ على نوعين: جماعي، وهؤلاء هم القسم الأكبر من الشهداء، والنوع الآخر أُفرد، لكل واحد منهم قبرٌ، وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهم العباس، وعلي الأكبر عليهما السلام، وحبيب بن مظاهر، والحرّ رضوان الله عليهم.
ثمّ نلاحظ أنّ الذين دُفنوا بشكل مستقلّ لم يُدفنوا جميعاً على نفس الغرار، بل يمكن تقسيمهم إلى قسمين أيضاً:
القسم الأول: مَن كان له روضةٌ مستقلّة وحرمٌ منفرد، وهما العباس والحرّ.
والقسم الثاني: مَن كان مدفوناً في نفس الروضة الحسينيّة، ولم يُفرد بمزار خاصّ وهما عليّ الأكبر وحبيب، فإنّهما وإن كان لكلّ منهما مرقد منفرد إلاّ أنّهما مشمولان بالحضرة الحسينيّة.
إنّنا إذا ما أردنا أن نحاول فَهْمَ الرموز والإشارات لهذا الاختلاف في طريقة الدفن، فإنّنا لا نملك نصوصاً من الأئمة المعصومين نستطيع على ضوئها بيان هذه الرموز والإشارات، ولكن يمكننا الاستعانة بما لدى أهل المعرفة من أدوات علميّة تساعدنا على فهم بعض ملامح الرموز والإشارات والحقائق والأسرار التي يمكن أن تستبطنها هذه العمليّة.
فالزائر حينما يكون خارج كربلاء تتركَّز في ذهنه صورة مشهد الحسين عليه السلام دون غيره من الشهداء بما فيهم العباس عليه السلام([114])، وحينما يدخل في وسط مدينة كربلاء تتركّز في ذهنه صورة لمشهدين شامخين، وروضتين مطهّرتين، هما الروضة الحسينيّة والروضة العباسيّة، ولا يلاحِظ غيرهما، وحينما يكون داخل الحائر تبرز لك ثلاثة قبور: هي قبر عليّ الأكبر، وقبر حبيب، وقبر يرمز إلى الشهداء بما هم مجموع لا بما هم أفراد، ولاحظ معي كيف أنّ هذه القبور الثلاثة كانت فانية في ضريح الحسين عليه السلام.
وعلى كلّ حال نريد هنا أن نلمح إلى بعض ما نفهمه من رموز وإيماءات وأسرار لطريقة دفن الشهداء، وسنتحدَّث عن رمزيّة الدفن الجماعي أولاً، ثمّ نتكلَّم عمّا يمكن فهمه من رموز الدفن المستقلّ.
إنّ الدفن الجماعي ربما فيه إيماءة وإشارة إلى كون هؤلاء الصفوة جميعهم يعيشون في مرتبة كماليّة واحدة، وهذه المرتبة هي ما يُعبِّر عنها العرفاءُ بـ(مرتبة الفناء في الله)، وقد حقق هؤلاء الخاصّة هذه المرتبة بجميع درجاتها ابتداءً من الفناء الأفعالي ومروراً بالفناء الصفاتي وانتهاءً بالفناء الذاتي الذي هو أعلى درجات الفناء، فإذا بلغ العارف هذه الدرجة ذهل عن كلّ شيء في هذا الوجود ما عدا الذات الإلهية المقدّسة.
وهذا هو كمال الانقطاع الذي أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في مناجاته: «إلهي هَبْ لي كمال الانقطاع إليك»([115]).
وهذا ما كان متحققاً في هؤلاء العظام، فكانوا لا يرون لذواتهم الشريفة أيّ أهمّية واستقلالية في قبال الذات الإلهيّة المقدَّسة، فذابوا ذوباناً مطلقاً وانصهروا انصهاراً صِرفاً في الذات الحسينيّة المقدّسة، التي كانت بالنسبة إليهم المرآة التي ينظرون من خلالها إلى الجمال الأزلي المطلق.
وممّا يدلل على هذه الحقيقة ما رواه القطب الراوندي في الخرائج والجرائح عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال الحسين بن علي عليهما السلام لأصحابه قبل أن يُقتل: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا بُني، إنّك ستساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى بها النبيون، وأوصياء النبيين، وهي أرض تُدعى عمورا، وإنّك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مسّ الحديد. وتلا: (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ) ([116])»([117]).
فإنّ عدم شعورهم بما وقع عليهم من الضرب والطعن والرشق نابع من عدم اكتراثهم بما يجري في عالم الكثرات، وانشغالهم التامّ بمشاهدة أنوار عالم الوحدة([118]).
وعدم الشعور بالألم أمر ممكن الوقوع وقد دلّ عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ) ([119]).
يقول السيد كمال الحيدري معلّقاً على الآية الكريمة: «فالنسوة هنا مع كونهن أضعف الناس إلاَّ أنّهن لم يجدن ألم قطع الأيدي عند لقاء يوسف عليه السلام، بل صحن بدهشة:( مَا هَذَا بَشَرًا) ، وقلن بوجد: (إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ) »([120]).
ويقول القشيري: «فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق، فما ظنُّك بمَن تكاشف بشهود الحقّ سبحانه؟! فلو تغافل عن إحساسٍ بنفسه وأبناء جنسه، فأيّ أعجوبة فيه؟!»([121]).
وإذا كان الدراويش والمتصوّفة يصلون بحضور زعيمهم الروحي إلى هذه المرتبة من عدم الإحساس بالألم بعد القيام ببعض الأعمال، فما ظنّك بهؤلاء الأفذاذ الذين قال عنهم الإمام الحسين عليه السلام: «لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي»([122]).
فلعل هذه هي الرسالة التي أراد أن يبعثها إلينا الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال الدفن الجماعي، وهذا هو المعنى الأسمى الذي ينبغي أن يستلهمه الزائر حينما يقف عند رجلي الإمام الحسين عليه السلام وينظر إلى تلك البقعة الطيبة التي ضمّت أوصال هؤلاء الشهداء.
ولعلّ الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام يؤكّدان هذا المعنى حينما علَّما شيعتهما أن تكون زيارتهم للشهداء بنحو جماعي أيضاً، فيزورهم الزائر بزيارة جماعية واحدة، وقد تضمّنت تلك الزيارات عباراتِ معصومٍ بليغة، كلّها تشير إلى تلك الحقيقة التي شرحناها آنفاً، ولا يسعنا أن ننقل هنا تلك الزيارات، ويمكنك أن تطلبها من كتابي كامل الزيارات ومفاتيح الجنان، ونحوهما.
الدفن الانفرادي قد خُصّ به من بين الشهداء أولئك القلّة الذين عبروا (مرتبة الفناء) واجتازوا جميع درجاتها من المحو والطمس والمَحق وتحققوا بـ(مرتبة البقاء بعد الفناء).
وإذا أردنا أن نتحدَّث بلغة دينيّة نقول: إنّ هذه المنزلة هي منزلة السفارة والوساطة بين الحقّ والخلق بألوان الفيوضات المادّية والمعنوية، وصاحب هذا المقام هو باب الله الذي منه يؤتى، ونوره الذي لم يَطفأ ولا يُطفأ أبداً، ووجهه الذي لم يهلك ولا يهلك أبداً، وهو عين الله التي يبصر بها ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، وبه يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، وبه يمسك الأرض أن تسيخ بأهلها.
فهذه العبارات ونظائرها وأشباهها ممّا ورد في الموروث الديني، كلّها تنطبق على أصحاب هذا المقام.
ولعلّ من هنا أُفرد لكل واحد منهم ضريح لكي يكون باباً يطرقه أهل الحاجات المادّية والمعنوية على حدّ سواء، وهذا ما ينطبق ـ بلا ريب ـ على العباس وعلي الأكبر عليهما السلام وحبيب بن مظاهر رضوان الله تعالى عليه.
العباس عليه السلام:
العباس عليه السلام هو من أوضح المصاديق التي ينطبق عليها هذا المعنى، كما أثبتنا ذلك في كتابنا (البُعد العرفاني في شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام) ويكفيك شاهداً على ذلك هذه الروضة المقدّسة، التي اختصّه الله سبحانه وتعالى بها، والتي تضاهي روضات الحجج المعصومين، وهذه الروضة هي من أوضح وأجلى مظاهر(البقاء بعد الفناء).
يقول السيد المقرَّم وهو يبيِّن السبب الذي من أجله ترك الحسين عليه السلام أخاه العباس عليه السلام على المُسنّاة: «إنّما تركه لسرّ دقيق، ونكتة لا تخفى على المتأمِّل ومَن له ذوق سليم، ولولاه لم يعجز الإمام عن حمله مهما يكن الحال، وقد كشفت الأيام عن ذلك السرّ المصون، وهو أن يكون له مشهد يُقصد بالحوائج والزيارات، وبقعة يزدلف إليها الناس، وتتزلَّف إلى المولى سبحانه تحت قبّته التي تحكي السماء رفعة وسناء، فتظهر هنالك الكرامات الباهرة، وتعرف الأمّة مكانته السامية ومنزلته عند الله، فتقدره حقّ قدره، وتؤدي ما وجب عليهم من الحبّ المتأكد، والزورة المتواصلة، ويكون عليه السلام حلقة الوصل بينهم وبين اللّه تعالى، وسبب الزلفى لديه. فشاء المهيمن تعالى شأنه وشاء وليه وحجّته أن تكون منزلة أبي الفضل الظاهرية شبيهة بالمنزلة المعنوية الأخروية، فكان كما شاءا وأحبّا. ولو حمله سيد الشهداء إلى حيث مجتمع الشهداء في الحائر الأقدس لغمره فضل الإمام الحجّة عليه السلام، ولم تظهر له هذه المنزلة التي ضاهت منزلة الحجج الطاهرين، خصوصاً بعد ما أكّد ذلك الإمام الصادق عليه السلام بإفراد زيارة مختصّة به، وإذناً بالدخول إلى حرمه الأطهر، كما شُرِّع ذلك لأئمة الهدى، غير ما يزار به جميع الشهداء بلفظ واحد، وليس هو إلاّ لمزايا اختصّت به»([123]).
ويبدو ـ والله العالم ـ أنّ لعلي الأكبر وحبيب بن مظاهر منزلة دون منزلة أبي الفضل العباس عليه السلام وفوق منزلة سائر الشهداء، فهما وإن لم يحظيا بما حظي به أبو الفضل العباس عليه السلام، فيكون لكلّ منهما روضة منفردة وعتبة مستقلّة، كما هو الحال بالنسبة لأبي الفضل العباس عليه السلام، إلاّ أنّ استقلال كلّ منهما بقبر منفرد ينبئ عمّا لهما من الخصوصية والفضل على سائر الشهداء.
ولا عجب في ذلك، فهناك الكثير من الأدلّة التاريخية التي تكشف عن ارتفاع شأن هذين العملاقين، وتميزهما على سائر الشهداء من الناحية المعنوية والكمالية، وكل مطَّلع على التراث الحسيني يدرك بأدنى درجات التأمُّل أنّ أقرب اثنين إلى الإمام الحسين عليه السلام بعد أبي الفضل العباس هما علي الأكبر وحبيب بن مظاهر.
وقد دفن الإمام السجاد عليه السلام أحدَهما مما يلي رأس الحسين عليه السلام، ودفن الآخر مما يلي رجليه؛ ليكونا بابَي الحسين عليه السلام وحاجبيه، كما كانا له في حياته.
الحرّ الرياحي رحمه الله:
وأما الحرّ فلا يشمله حديثنا السابق؛ إذ لو شمله لكانت منزلته تضاهي منزلة أبي الفضل العباس عليه السلام وتفوق منزلة علي الأكبر وحبيب بن مظاهر فضلاً عن سائر الشهداء، وفي إفراد مرقده يوجد من الناحية الرمزية والإشارية احتمالان:
الاحتمال الأول: أنّه فيه دلالة على عدم مساواته ببقية الشهداء وأنّه دونهم في الفضل، وذلك لأنّه كان في بداية أمره ممّن خرج لحرب الحسين عليه السلام، وقد جعجع به في الطريق وحبسه عن الرجوع، وأدخل الرعب في قلوب النساء والأطفال؛ ولذا لم يُحمل إلى الشهداء لكي يُدفن معهم.
جاء في رواية أسرار الشهادة ـ التي نقلناها سابقاً ـ أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام قال للأسديين بعدما فرغوا من مواراة الشهداء: «هلمّوا لنوارِ جثّة الحرّ الرياحي. قال: فتمشّى وهم خلفه حتى وقف عليه، فقال: أمّا أنت فقد قبل اللّه توبتك، وزاد في سعادتك ببذلك نفسك أمام ابن رسول اللّه عليه السلام. قال: وأراد الأسديون حمله إلى محل الشهداء، فقال: لا، بل في مكانه واروه»([124]).
فالإمام السجاد عليه السلام مع أنّه قد شهد له في هذا النصّ بقبول توبته وأنّه من أهل السعادة، غير أنّه منع الأسديين من حمله إلى محل الشهداء، وأمرهم بمواراته في مكانه، وهذا يعني أنّه أقلّ منزلة منهم، وهذا هو الرأي الذي كان عليه الكثير من الناس حتى قال أحدهم:
|
أشر للحرّ من قرب وبعد
|
|
فإنّ الحرّ تكفيه الإشارة
|
ولكن بعدما نبش قبره الشاه إسماعيل الصفوي، وظهرت للناس كرامته بدأ كثير من الناس يتخلَّون عن هذا الرأي، وشرعوا بالاهتمام بقبره وزيارته، وكان سبب هذه الحادثة هو ما سمعه الشاه من طعن العلماء فيه وقد نقلنا هذه الحكاية سابقاً([125]).
الاحتمال الثاني: وهو ما نرجّحه ونتبنّاه بقوّة، وهو أنّ الحرّ الرياحي كان يتمتع بخصوصيته من بين شهداء الطفّ، فقد كان ممّن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالوقوف في مفترق طريقين: طريق يؤدي إلى السعادة الدائمة، وطريق يؤدي إلى الشقاء الأبدي، فكان يُخيِّر نفسه بين هذين الطريقين، وفي الأخير انتصر على هواه بعد صراع مرير، واختار الطريق الأول والتحق بركب الخلود وفاز بالنعيم المقيم.
فالحرّ رضوان الله تعالى عليه كان رمزاً لتحرر الروح من أصفاد المادّة، ورمزاً لانتصار نوازع الخير على نوازع الشرّ، ورمزاً لتغلُّب الحبّ الإلهي على حبّ الدنيا.
ومن هنا نجد الخطباء قد دأبوا على تخصيص يوم من عشرة عاشوراء إحياء لذكرى الحرّ، وتخليداً لموقفه لتميزه وتفرده بذلك.
ولعلّ الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يكرِّس هذه الرمزية للحرّ، فمنع الأسديين من حمله وأمرهم بمواراته حيث مرقده الآن؛ لكي تقف الأجيال اللاحقة بكلّ خشوع أمام ضريح هذا العملاق، وتستلهم منه تلك المعاني السامية التي جسّدها في ساحة كربلاء.
قد لا أكون توصلت إلى نتائج نهائية وقطعيّة في كثير من مطالب هذه الدراسة، ولكنني ـ بلا ريب ـ قد خطوت خطوة أو خطوات باتّجاه الحقيقة، ووضعت لبنة أو عدّة لبنات في البناء الذي بدأ به غيري، ومهدّت الطريق لمَن يأتي بعدي من الباحثين، وحسبي أنّني نبّهت الباحث على المشاكل الرئيسة في هذا العمل، وفتحت عينيه على أمهات مصادره ومراجعه.
إنّ تراكم البحوث والدراسات في حقل من الحقول هو الطريق الأمثل والأنجع لازدهار ذلك الحقل ونموه وتقدّمه، فإذا كانت لدينا مثلاً ثلاثة آراء في موضوع ما، فليس بالضرورة أن تأتي برأي رابع لكي تكون مبدعاً، فإنّ هناك مجالاً آخراً للإبداع، وهو أن تتبنّى أحد الآراء المطروحة وتقوم بتطويره ـ على مستوى الطرح أو الاستدلال ـ وهذا ما يسمى بالمعرفة التراكمية، ولولا هذا التراكم في المعرفة لما تطورت العلوم، ولما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه الآن من تقدُّم على كافّة الأصعدة.
بعد القرآن الكريم
حرف الألف
1ـ إثبات الوصية، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، دار الأندلس، بيروت، ط1، 1430هـ.
2ـ الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري (ت 280 هـ)، تحقيق عبد المنعم عامر، مراجعة جمال الدين الشيال، دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة، ط1، 1960م.
3ـ أدب الطفّ، جواد شبر، مؤسسة التاريخ، بيروت، ط1، 1422هـ.
4ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بـ (المفيد) (ت 413هـ)، تحقيق حسين الأعلمي، مؤسسة النبراس، النجف الأشرف، ط5، 2001م.
5ـ أسرار الشهادة، آغا بن عابد الشرواني الحائري المعروف بـ(الفاضل الدربندي) (ت 1285هـ)، منشورات ذوي القربى، قم المقدسة.
6ـ الأسرار الحسينيّة، جمع وإعداد وتحقيق راضي ناصر السلمان، دار المحجة البيضاء، ط2، بيروت، 2009م.
7ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
8ـ الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي (ت460ه)، انتشارات دار الثقافة، قم المقدّسة، 1414هـ.
9ـ أمل الآمل، محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104هـ) تحقيق أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف الأشرف.
1ـ أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود البلاذري (ت279هـ)، دار الفكر، بيروت، ط1، 1996م.
11ـ أنصار الحسين عليه السلام، محمد مهدي شمس الدين، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، ط 3، 2008م.
12ـ إبصار العين في نصرة الحسين عليه السلام، محمد طاهر السماوي ، تحقيق الشيخ محمد جعفر الطبسي، ط1، 1419 مركز الدرسات الإسلامية.
حرف الباء
12ـ بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي (ت1111 هـ)، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط 2، 1983م.
13ـ البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ)، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1988م.
14ـ بطل العلقمي، عبد الواحد المظفر، دار الحوراء، بيروت، ط 1، 2009م.
حرف التاء
15ـ تاريخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1407هـ.
16ـ تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف مكرم، مكتبة الدراسات الفلسفية، ط5.
17ـ تاريخ النياحة، صالح الشهرستاني، تحقيق نبيل رضا علوان، مؤسسة أنصاريان، قم المقدسة، ط2، 2005م.
18ـ تذكرة الفقهاء، العلاّمة الحلي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم المقدسة، ط1، 1414 ه.
حرف الجيم
19ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي (ت 1266هـ)، تحقيق وتعليق عباس القوجاني، دار الكتب الإسلامية، طهران.
حرف الحاء
20ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني (ت 1186هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسِين، قم المقدسة.
حرف الخاء
21ـ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، قم المقدّسة، ط1، 1409هـ.
22ـ الخصائص الحسينيّة، جعفر التستري، دار الحوراء، بيروت .
حرف الدال
23ـ الدمعة الساكبة، محمد باقر بن عبد الكريم البهبهاني الدهدشتي (ت 1285)، مكتبة العلوم العامة في المنامة ومؤسسة الأعلمي في بيروت، 1408هـ.
24ـ دور الأئمة والأنبياء في واقعة كربلاء، توفيق علوية العاملي، دار المتّقين، بيروت، ط1، 2010م.
حرف الذال
25ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغا بزرك الطهراني (1389 هـ)، دار الأضواء، بيروت.
26ـ ذخيرة الدارين، عبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الحائري الشيرازي، تحقيق باقر درياب النجفي، مركز الدراسات الإسلامية التابع لممثلية الولي الفقيه.
حرف الراء
27ـ الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق د. عبد الحليم محمود، و د. محمود بن الشريف، الناشر بيدار، قم المقدسة، ط1، 1374ش.
28ـ رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة على إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، جواد التبريزي، سلسلة الكتب العقائدية (100)، مركز الأبحاث العقائدية.
29ـ رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسِين، قم المقدّسة، ط1، 1412هـ.
حرف الزاي
30ـ زين العابدين عليه السلام، السيد عبد الرزاق المقرّم، بدون تاريخ.
حرف الشين
31ـ شجرة طوبى، محمد مهدي الحائري، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف الأشرف، ط 5، 1385هـ.
32ـ الشعائر الحسينيّة بين الأصالة والتجديد، محاضرات الشيخ محمد السند، تقرير السيد رياض الموسوي، دار الغدير، قم المقدّسة، ط1، 2003م.
حرف العين
33ـ العباس عليه السلام، السيد عبد الرزاق المقرَّم، سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام، مركز الأبحاث العقائدية.
حرف الفاء
34ـ فاجعة الطفّ، محمد سعيد الحكيم، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية، ط2، 2009م، النجف الأشرف .
. 35ـ فقه الصادق عليه السلام، محمد صادق الروحاني، مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، المطبعة العلمية، ط3، 1412هـ
36ـ الفوائد الرجالية، مهدي بحر العلوم، مكتبة الصادق عليه السلام، طهران، ط1.
حرف القاف
37ـ قراءة في رسالة التنزيه، محمد الحسون، سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام (136)، مركز الأبحاث العقائدية.
حرف الكاف
38ـ الكافي، الكليني، تحقيق علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط5، 1388هـ.
39ـ كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، دار المرتضى، بيروت، ط1، 2008م.
40ـ الكامل في التاريخ، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المشهور بـ(الأثير) (ت630 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ.
41ـ الكُنى والألقاب، عباس القمّي، بدون تاريخ.
حرف اللام
42ـ اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسيني (ت 664 هـ)، المطبعة الحيدرية،1950م.
حرف الميم
43ـ المبسوط في فقه الإمامية، محمد بن الحسن الطوسي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
44ـ المجالس السَّنيّة، السيد محسن الأمين (ت 1371 هـ)، ط 5، 1974م، بيروت.
45ـ محاضرات في الثورة الحسينية، محمود الهاشمي، مطبعة الأميرة، بيروت، ط1، 2011م.
46ـ مروج الذهب، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط5، 1387هـ.
47ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، أحمد بن محمد مهدي النراقي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مشهد المقدسة، ط1، 1415هـ.
48ـ مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، محمد جعفر الطبسي ومجموعة من العلماء، مركز الدراسات الإسلامية لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية، قم المقدسة، 1323هـ.
49ـ مفاتيح الجنان، عباس القمّي، طبعة مسجد جمكران المقدّس، قمّ المقدسة.
50ـ مقتل الحسين عليه السلام، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن مسلم الأزدى الغامدي (ت قبل151 هـ، وقيل 157 هـ)، من منشورات المكتبة العامة للسيد شهاب الدين المرعشي، المطبعة العلمية، قم المقدسة، 1398هـ.
51ـ مقتل الحسين عليه السلام، أبي المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي (ت 568 هـ)، انتشارات أنوار الهدى، قم المقدسة، ط5، 1431هـ.
52ـ الملحمة الحسينية، مرتضى مطهري، تحقيق ومراجعة عبد الكريم الزهيري، الزهيري للطباعة والنشر، ط1، 2009م.
53ـ مناقب آل أبي طالب، مشير الدين أبى عبدالله محمد بن على بن شهر آشوب بن أبى نصر بن أبى حبيشى السروي المازندراني (588هـ)، تحقيق مجموعة من أساتذة النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1956.
54ـ مناهج البحث في العلوم السياسية، محمد محمود ربيع، مكتبة الفلاح، الكويت، ط2، 1987م.
55ـ من الخلق إلى الحقّ، من أبحاث السيد كمال الحيدري، طلال الحسن، دار فراقد، قم المقدسة، ط1، 2005م.
56ـ المنتخب في جمع المراثي والخطب، فخر الدين الطريحي (ت 1085 هـ )، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، 1384هـ.
57ـ المنطق الإسلامي، محمد تقي المدرسي، بدون تاريخ.
58ـ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، مير حبيب الله الهاشمي الموسوي الخوئي، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم المقدّسة.
حرف النون
59ـ نظرية السنّة في الفقه الإمامي، حيدر حبّ الله، الانتشار العربي، بيروت، ط1، 2006م.
60ـ نهضة الحسين عليه السلام، هبة الدين الحسيني الشهرستاني (ت 1386هـ)، سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام، مركز الأبحاث العقائدية.
الأمر الأول: أهمّية البحث.. 17
بعض الأحكام الفقهية للحائر: 20
الأمر الثاني: تبويب البحث وهيكليته. 21
المبحث الأول/ تحديد زمان الدفن.. 25
القول الأول: دفن الشهداء تمّ في اليوم الحادي عشر من المحرّم: 27
مؤرّخو الشيعة والدفن في اليوم الحادي عشر: 29
القول الثاني: دفن الشهداء في اليوم الثالث عشر من المحرم: 32
الرأي الراجح في مسألة زمان الدفن هو اليوم الثالث عشر: 33
شواهد ومؤيدات لحصول الدفن في اليوم الثالث عشر: 34
أولاً: اشتهاره على ألسنة أُدباء الطفّ... 34
ثانياً: الخلل في دلالة وصحّة قولهم إنّ الدفن كان في اليوم الحادي عشر. 39
ثالثاً: حضور الإمام زين العابدين عليه السلام عمليةَ الدفن. 42
رابعاً: عمل الطائفة على أنّ الدفن في اليوم الثالث عشر. 44
المبحث الثاني/ التخطيط الإلهي في كيفية دفن شهداء الطف... 48
حادثة عاشوراء والتخطيط الإلهي: 51
التفسير الغيبي لواقعة الطفّ: 54
طريقة دفن شهداء الطفّ تخطيط إلهي: 56
الآلية الأولى: الأُسلوب الغيبي البحت.. 57
الآلية الثانية: حضور الإمام زين العابدين عليه السلام. 59
إعراض مصادر الطفّ المعتبرة عن هذه الروايات.. 70
الاحتمال الأول: عدم اطّلاع المتقدِّمين على هذه الروايات.. 70
الاحتمال الثاني: اطّلعوا عليها ولم ينقلوها 72
الاحتمال الثالث: عدم نقل المتقدّمين للروايات تقيةً. 74
المبحث الثالث/ كيفية الدفن وتعيين قبور الشهداء... 76
تعيين قبور الشهداء بحسب الأدلة التاريخية: 79
1ـ ضريح الإمام الحسين عليه السلام: 80
2ـ ضريح علي بن الحسين عليهما السلام: 80
3ـ ضريح الشهداء (بني هاشم والأنصار): 81
الأقوال في كيفيّة دفن الشهداء بشكل جماعي: 82
القول المختار في تعيين قبور الشهداء: 85
اعتراض الشيخ المظفر على الدفن الجماعي للشهداء: 86
أجوبة وملاحظات على الاعتراض: 87
4ـ ضريح حبيب بن مظاهر الأسدي: 91
ضريحان خارج الحائر الحسيني: 93
1 ـ ضريح العباس عليه السلام: 93
المبحث الرابع/ الجانب الرمزي في عملية الدفن.. 99
علي الأكبر وحبيب بن مظاهر: 108
([1]) اُنظر: السلمان، راضي ناصر، الأسرار الحسينية: ص13، دار المحجة البيضاء، ط21، 2009م.
(([2] الشهرستاني، هبة الدين الحسيني، نهضة الحسين عليه السلام: ص178، (سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام، مركز الأبحاث العقائدية).
([3]) اختلف الفقهاء في تحديد الحائر وتقدير مساحته سعةً وضيقاً، «فعن المفيد(ره): إنّ الحائر محيط بهم إلاّ العباس عليه السلام، وعن السرائر: ما دار سور المسجد والمشهد علي، دون ما دار سور البلد عليه. وعن بعض: أنّه مجموع الصحن الشريف. وعن بعض: أنّه القبّة السامية. وعن بعض: أنّه الروضة المقدسة. وعن المجلسي أنّه مجموع الصحن القديم». وهذا الاختلاف نابع من اختلاف الروايات. راجع: الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق عليه السلام: ج6، ص 429 ـ 430، )المطبعة العلميّة، ط3، 1412هـ(.
([4]) كذا في المصدر، والصحيح (خمسة فراسخ من أربعة جوانب).
([5]) الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة (آل البيت): ج14، ص510.
([6]) المصدر نفسه: ج14، ص511.
([7]) المصدر نفسه: ج14، ص512.
([8]) انظر: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ج10، ص275. (مؤسسة النشر الإسلامي).
(([9] اُنظر: المصدر نفسه: ج7، ص260.
(([10] اُنظر: المصدر نفسه: ج8، ص524.
([11]) اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج36، ص424. (دار الكتب الإسلامية).
([12]) المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ص170. (تحقيق حسين الأعلمي، مؤسسة النبراس، النجف الأشرف، ط 5، 2001م).
([13]) ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص 305. (تحقيق مجموعة من أساتذة النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1956).
([14]) ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص63. (المطبعة الحيدرية، 1950م).
(([15] الطريحي، فخر الدين، المنتخب في جمع المراثي والخطب: ج1، ص237. (المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، 1384 هـ).
([16]) الأمين، محسن، المجالس السَّنيِّة: ج1، ص 128. (ط5، 1974م، بيروت).
(([17] الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص260. (دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة، ط1، 1960م).
([18]) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص335. (دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1407 هـ).
([19]) المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج3، ص72. (مطبعة السعادة، مصر، ط5، 1387هـ ).
([20]) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص205. (دار إحياء التراث العربي، ط1، 1988م).
([21]) اُختلف في معتقد المسعودي وميوله المذهبية، فقد ذكره علماء الشيعة في كتبهم الرجالية، ومنهم النجاشي، الذي أفاد بأنّ له كتباً في الإمامة. رجال النجاشي: ص254. بل هناك من علماء الشيعة مَن صرّح بأنّ المسعودي شيعي، كابن إدريس الحلي في السرائر: ج1، ص651، والسيد علي بن طاووس في فرَج المهموم: ص126، ومهدي بحر العلوم في الفوائد الرجالية: ج4، ص150، والمازندراني في منتهى المقال: ج4، ص391، وغيرهم.
بينما جعله الذهبي معتزلياً، في سير أعلام النبلاء: ج15، ص596، وأورده السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: ج3، ص456. ويظهر من كتابه مروج الذهب وكتابه التنبيه والإشراف، أنّ الرجل من أهل السنّة، نعم كتاب إثبات الوصيّة يثبت خلاف ذلك، وهناك من يشكك في نسبة الكتاب إليه.
([22]) الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص335.
(([23] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص205. (دار الفكر، بيروت، ط1، 1996م).
([24]) المسعودي، علي بن الحسين بن علي، مروج الذهب: ج3، ص63.
(([25] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج2، ص178. (دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415 هـ.).
([26]) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص205.
([27]) الخوارزمي، أبو المؤيد الموفق بن أحمد، مقتل الحسين: ج2، ص44. (انتشارات أنوار الهدى. قم المقدّسة، ط5، 1431هـ).
([28]) المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص114.
([29]) ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفّوف: ص85.
([30]) ممَّن نسب هذا القول إلى هؤلاء المؤرِّخين محمد جعفر الطبسي في كتابه مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، حيث قال ـ بعد أن ذكر مؤرِّخي السنّة القائلين بأنّ الدفن قد حصل في اليوم الحادي عشرـ: «ويوافقهم في هذا الرأي أبرز مؤرّخي الشيعة، كالمسعودي أيضا،ً حيث يقول: ودفن أهلُ الغاضريّة ـ وهم قوم من بني غاضر من بني أسد ـ الحسينَ وأصحابه بعد قتلهم بيوم. والشيخ المفيد (ره) حيث يقول: ولمّا رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد، كانوا نزولاً بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه رحمة اللّه عليهم، فصلّوا عليهم، ودفنوا الحسين عليه السلام حيث قبره الآن، ودفنوا ابنه عليَّ بن الحسين الأصغر عند رجليه، وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين صُرعوا حوله ممّا يلي رجلي الحسين عليه السلام وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً، ودفنوا العبّاس بن عليّ عليهما السلام في موضعه الذي قُتل فيه على طريق الغاضريّة حيث قبره الآن. وذهب إلى ذلك السيد ابن طاووس (ره) أيضاً، حيث يقول: ولمّا انفصل عمر بن سعد لعنه اللّه عن كربلاء خرج قوم من بني أسد، فصلّوا على تلك الجثث الطواهر المرملة بالدماء، ودفنوها على ماهي الآن عليه». الطبسي، محمد جعفر، مع الركب الحسينيّ من المدينة إلى المدينة: ج5، ص291. (قم المقدسة، 1323هـ.).
(([31] ابن شهر آشوب، مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص305.
([32]) اُنظر: المصدر السابق: ج1، ص7.
(([33] الأمين، محسن، المجالس السنية: ج1، ص128.
(([34] المقرَّم، عبد الرزاق، زين العابدين عليه السلام: ص402.
([35]) التستري، جعفر، الخصائص الحسينية: ص344. (دار الحوراء، بيروت).
(([36] المصدر نفسه: ص 308.
([37]) المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج 3، ص 259. (دار الحوراء، بيروت، ط1، 2009م).
([38]) الحائري، محمد مهدي، شجرة طوبى: ج1، ص75. (منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف الأشرف، ط5، 1385 هـ).
(([39] المصدر السابق: ج2، ص 235.
([40]) المصدر نفسه: ج2، ص 448.
([41]) الطريحي، فخر الدين، المنتخب في جمع المراثي والخطب: ج2، ص214.
[42])) اُنظر: شبر، جواد، أدب الطفّ: ج1، ص196. (مؤسسة التاريخ، بيروت، ط1، 1422هـ).
[43])) بحر العلوم، مهدي، الفوائد الرجالية: ج3، ص36 ـ 37. (مكتبة الصادق، طهران، ط1).
([44]) يقول السيد جواد شبر: «ولا أبالغ إذا قلت: إنّي نخلت أكثر من خمسين ديواناً من دواوين الشعراء في القرون المتقدمة، وقرأت كلّ بيت من أبياتها عسى أن يكون هناك بيت يخصّ الموضوع، وسبرت كثيراً من الدواوين، وتركتها والنفس غير طيبة بقرأتها، تركتها والأمل لم يزل متّصل بها والحسرة تتبعها؛ ذلك أنّي لا أؤمن أنّ أمثال أولئك الشعراء الفطاحل لم ينظموا في يوم الحسين مع ما عُرفوا به من الموالاة والمفاداة لأهل البيت صلوات الله عليهم، فهل تعتقد أنّ أمثال أبي تمام والفرزدق وابن الرومي والبحتري والحسين الطغرائي وصفي الدين الحلي والمتنبي وأضرابهم لم يقولوا في الحسين، ولم يذكروا يومه ويتأثروا بموقفه البطولي، مع أنّ يوم الحسين هزّ العالم هزّاً عنيفاً لا زال صداه يملأ الآفاق.
إن الكثير من تراثنا الأدبي ضاع وأهمل وغطّت عليه يد العصبية في الأعصر الأموية وتوابعها في عصور الجهل والعقلية المتحجرة». شبر، السيد جواد، أدب الطفّ: ج3، ص5.
([45]) ابن شهر آشوب، مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي: ج3, ص259.
([46]) القمّي، عباس، الكنى والألقاب: ج2، ص272.
(([47] انظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، أمل الآمل: ج2، ص261ـ 262. (مطبعة الآداب، النجف الأشرف).
[48])) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص94. (دار المرتضى، بيروت، ط1، 2008م).
([49]) اُنظر: مطهري، مرتضى، الملحمة الحسينيّة: ج3، ص382. (الزهيري للطباعة والنشر، ط1، 2009).
([50]) وفي طليعة القائلين بذلك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص336، وأحمد بن يحيى بن جابر بن داوود البلاذري في أنساب الأشراف: ج3، ص 206.
([51]) وفي مقدِّمة القائلين بذلك: أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري في الأخبار الطوال: ص259. وقد تابعه على ذلك عدد من المؤرِّخين، منهم: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المشهور بـ( ابن الأثير ) في الكامل في التاريخ: ج3، ص185.
([52]) المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3، ص260.
([53]) الشهرستاني، هبة الدين، نهضة الحسين: ص178.
(([54] الشهرستاني، صالح، تاريخ النياحة: ج1، ص63. (مؤسسة انصاريان، قم المقدسة، ط2، 2005م).
([55]) قد يقال: إنّه ينبغي أن يساق حضور الإمام زين العابدين عليه السلام كدليل مستقلّ، لا قرينة مرجِّحة، خصوصاً أنّنا سنعقد له مبحثاً مستقلاً ونحاول فيه إثباته.
والجواب: إنّ هناك فرقاً بين نفس حضور الإمام زين العابدين عليه السلام وبين حضوره مقيداً بكونه في اليوم الثالث عشر، فالذي سنعقد له مبحثاً مستقلاً هو نفس الحضور مجرّداً عن تقييده بزمان محدّد، والذي سقناه كقرينة ـ هنا ـ هو حضوره مقيداً بكونه في اليوم الثالث عشر، ولا ملازمة بين الأمرين، فقد يثبت المؤرِّخ نفس الحضور، وفي ذات الوقت ينفي كونه في اليوم الثالث عشر، وإذا كان نفس الحضور يستند إلى بعض النصوص التاريخية ـ كما سنرى ـ فإنّ كون الحضور في اليوم الثالث عشر هو مجرّد استنتاج من بعض القرائن والشواهد، ولا يستند إلى نصّ تاريخي صريح.
([56]) اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص470. (مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث(.
([57]) اُنظر: الطبسي، محمد جعفر، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة: ج5، ص2.
([58]) المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3، ص269.
([59]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص279. ( تحقيق علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط5، 1388هـ).
( ([60]المصدر نفسه: ج1، ص279ـ280.
([61]) المصدر نفسه: ج1، ص281.
(([62] المصدر نفسه: ج1، ص283.
([63]) اُنظر: العاملي، توفيق علوية، دور الأئمة والأنبياء في واقعة كربلاء: ص 36. (دار المتقين، بيروت، ط1، 2010م).
([64]) الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطفّ: ص14. (مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية، النجف الأشرف، ط2، 2009م).
(([65] اُنظر: الهاشمي، محمود، محاضرات في الثورة الحسينية: ص28وما بعدها. (مطبعة الأميرة، بيروت، ط1، 2011م).
(([66] لمزيد من الاطّلاع على نظرية (كونت) يمكنك مراجعة: تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف مكرم: ص317 ـ 320، (مكتبة الدراسات الفلسفية، ط5)، ومناهج البحث في العلوم السياسية، لمحمد محمود ربيع: ص99 وما بعدها، (مكتبة الفلاح، الكويت، ط2، 1987م)، والمنطق الإسلامي، للسيد المدَّرسي: ص79.
([67]) الطبسي، محمد جعفر، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة: ج5، ص292.
([68]) ابن شهر آشوب، مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص259.
(([69] الطوسي، أبو جعفر بن محمد بن الحسن، الأمالي: ص315. (انتشارات دار الثقافة، قم المقدسة، 1414هـ).
(([70] المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3، ص262.
([71]) التبريزي، جواد، رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة على إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام: ص19.
([72]) المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3، ص262ـ 263.
(([73] الكليني، أبوجعفر محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص570.
([74]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج27، ص 288. (مؤسسة الوفاء، بيروت، ط 2، 1983م).
([75]) المقرَّم، عبد الرزاق، زين العابدين عليه السلام: ص402.
([76]) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ص288 ـ 289. (ط بمبئ). والمسعودي، علي بن الحسين، إثبات الوصية: ص220ـ221. ( دار الأندلس، بيروت، ط1، 1430هـ).
([77]) الدربندي، آغا بن عابد الشرواني، أسرار الشهادة: ج3، ص170. ( منشورات ذوي القربى، قم المقدسة).
([78]) اُنظر: البهبهاني، محمد باقر بن عبد الكريم، الدمعة الساكبة: ج11، ص5 ـ 14. (مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1408 هـ).
(([79] اُنظر: الحسون، محمد، قراءة في رسالة التنزيه: هامش ص102. (مركز الأبحاث العقائدية).
([80]) اُنظر: الطهراني، آغا بزرك، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج3، ص46 ـ 47. (دار الأضواء، بيروت).
([81]) المقرَّم، عبد الرزاق، زين العابدين عليه السلام: ص402.
([82]) السند، محمد، الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: ص 229. (تقرير السيد رياض الموسوي، دار الغدير، قم المقدسة، ط 1، 2003م).
(([83] انظر: حب الله، حيدر، نظرية السنّة في الفقه الإمامي: ص276. (الانتشار العربي، بيروت، ط1، 2006م).
([84]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1، ص3 ـ 4.
([85]) السند، محمد، الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: ص226. ( تقرير السيد رياض الموسوي).
([86]) تعرَّض القبر الشريف للهدم عدّة مرات، حيث هدمه المنصور الدوانيقي، ثمّ هدمه هارون العباسي وقطع السدرة التي كانت علامة على القبر، ثمّ هدمه مرّة أخرى بعد تجديد بنائه. ثمّ بُني بعد هارون في عهد المأمون، ثمّ هدمه المتوكل عدّة مرات وأجرى الماء عليه. هذا هو المذكور تاريخياً من مصادر العامّة والخاصّة، وبالدقّة نذكر السنوات التي هُدِمَ فيها قبر الحسين عليه السلام على يد المتوكل وغيره من خلفاء بني العباس، وهي: سنة 233 هـ، سنة 236 هـ، سنة 247 هـ، وفي سنة 273 هـ، والمرّة الخامسة هدم القبرَ الموفقُ ابن المتوكل، فهذه خمس مرات هُدم فيها القبر الشريف.
وهذه شواهد تاريخية على أنّ زيارة قبره عليه السلام كانت أمراً تحرص سلطات بني أُميّة وبني العباس على منعه، ووضع العيون لمعرفة زائريه، والتصدّي لهم بشكل شديد وخطير، بل زاد العباسيون طغياناً، فكانت زيارته عليه السلام تعتبر تعريض النفس للهلاك، أو تعريضاً لتلف عضو، وقد قُطعت الأيدي ـ كما هو المأثور ـ في سبيل زيارته عليه السلام. اُنظر: السند، محمد، الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: ص354 ـ 355. (تقرير السيد رياض الموسوي).
([87]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص180.
([88]) ابن قولويه، جعفر بن محمد ، كامل الزيارات: ص226.
([89]) الأمين، محسن، المجالس السَّنيّة: ج1، ص128.
(([90] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ص170.
([91]) اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص471.
(([92] اُنظر: الطريحي، فخر الدين، المنتخب في جمع المراثي والخُطب: ج1، ص37- 38.
([93]) المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ص174- 175.
([94]) شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين عليه السلام: ص179. (مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، ط3، 2008م).
(([95] المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3، ص258.
([96]) المقرَّم، عبد الرزاق، زين العابدين عليه السلام: ص402.
([97]) المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3، ص258ـ 259.
(([98] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ص174.
(([99] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج4، ص141.
([100]) اُنظر: المصدر نفسه، والطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الامامية:ج1، ص155، (المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية). والعلاّمة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: ج4، ص248، (مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء التراث، قم المقدسة، ط1، 1414هـ). والطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج2، ص239، (مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، ط1، 412 هـ). والنراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص305. (مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء التراث، مشهد المقدسة، ط1، 1415هـ).
([101]) الخوئي، مير حبيب الله الهاشمي الموسوي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج 18، ص9. (مؤسسة المطبوعات الدينية، قم المقدسة).
([102]) الدربندي، آغا بن عابد الشرواني، أسرار الشهادة: ج3، ص170.
([103]) الأمين، محسن، المجالس السَّنيّة: ج1، ص128.
(([104] الشيرازي، عبد المجيد بن محمد رضا الحسيني، ذخيرة الدارين: ص45. (تحقيق باقر درياب النجفي، مركز الدراسات الإسلامية التابع لممثلية الولي الفقيه). ولكننا لم نعثر على هذا النصّ في الحلية في الطبعات المتوفرة لدينا).
([105]) نعني بالنصوص السابقة: هي النصوص التي تحدَّثت عن دفن جميع الشهداء في مكان واحد، فإنّها نصوص مطلقة تشمل جميع الشهداء ـ بما فيهم حبيب بن مظاهر الأسدي ـ فلولا النصوص التي تحدَّثت عن إفراده بضريح مستقلّ لكان مقتضى إطلاق تلك النصوص كونه معهم.
(([106] الأزدي، أبو مخنف يحيى بن لوط، مقتل الحسين عليه السلام: ص147.
([107]) السماوي، محمد طاهر، إبصار العين في نصرة الحسين عليه السلام: ص106. (تحقيق الشيخ محمد جعفر الطبسي، ط1، 1419 مركز الدرسات الإسلامية).
([108]) المظفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3، ص255.
(([109] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ص170.
([110]) المقرَّم، عبد الرزاق، العباس عليه السلام: ص260.
([111]) المصدر السابق: ص261-262.
(([112] المصدر نفسه: ص262.
(([113] المصدر السابق: ص261.
([114]) بل أخبرني بعضهم أنّ الزائر القادم من خارج العراق لزيارة المشاهد المشرّفة حينما يُسأل عن قصده يقول: إنّي قاصد لزيارة الحسين عليه السلام، مع أنّه قاصد لزيارة جميع الأئمة المدفونين في العراق، وهذا أمر يدعو إلى وقوفٍ عنده، والتأمّل فيه.
(([115] القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: ص174. (طبعة: مسجد جمكران المقدّس، قم المقدسة).
(([116] الأنبياء: 69.
([117]) الراوندي، قطب الدين، الخرائج والجرائح: ج2، ص353. (مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، قم المقدّسة، ط1، 1409هـ).
([118]) نحن لا نوافق على ما ذهب إليه الرشتي في عدّه ما خلا العباس والأكبر عليهما السلام من أنصار الحسين عليه السلام من أهل الظاهر، حيث قال ـ كما نقله راضي ناصر السلمان في الأسرار الحسينية الذي سبق ذكره، ص126 ـ: «وأمّا غيرهما [يعني غير العباس وعلي الأكبر عليهما السلام] من الأصحاب، فلم يقف على شيء يدلّ على اطّلاعهم على علوم الأسرار، وحقائق الأنوار، ومراتب التوحيد، ومقامات التفريد والتجريد ...».
فهذا الكلام لا يمكن التسليم به، وأقلّ ما يرد عليه هو أنّه حتى لو سلّمنا معه بهذا الكلام، فإنّه لا يصحّ له تعميم هذا الحكم بهذه الطريقة، فإنّنا نعلم يقيناً بأنّ حبيب بن مظاهر ـ مثلاً ـ كان من جملة خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام ومن حمَلَة أسراره بنصّ العديد من المؤرِّخين.
(([119] يوسف: 31.
([120]) الحيدري، كمال، من الخلق إلى الحقّ: ص 84. ( تقرير طلال الحسن، دار فراقد، قم المقدسة، ط1، 2005م).
(([121] القشيري، عبد الكريم بن هوازن، الرسالـة القشيـرية: ص140. (تحقيـق د. عبد الحـليم محـمــود، و د. محمود بن الشريف، الناشر بيدار ، قم المقدسة، ط1، 1374 ش).
(([122] السماوي، محمد طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين عليه السلام: ص23.
([123]) المقرَّم، عبد الرزاق، العباس عليه السلام: ص 258- 259.
([124]) الدربندي، آغا بن عابد الشرواني، أسرار الشهادة: ج3، ص170.
([125]) في المبحث الثالث ـ ضريح الحرّ الرياحي.