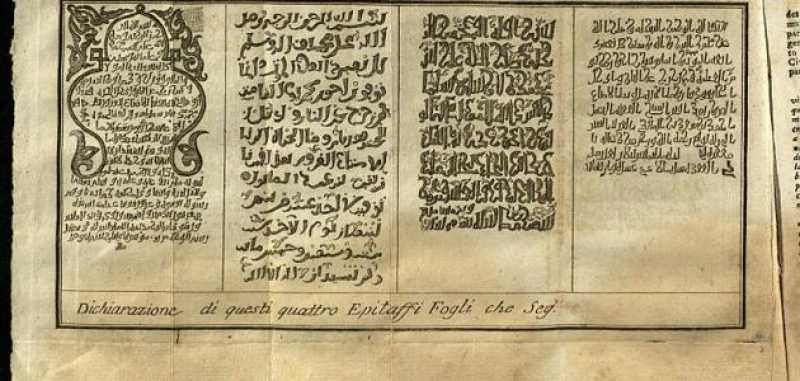علي ســلمان ســاجت
ان القصيدة،هذا اللون الفاعل والحيوي في الثقافة العالميـة والذي له القدرة في آحايين عديدة على بناء او تقويض الكثير من البنى والأسس المتشكلة في أفكار الشعوب والجماعات بل له القدرة أحيانا على تثوير العزائم وأستنارة العقول وتأجيج الحماس مما دفع بالكثير من الشعوب والقبائل الى تخليدها وتمجيدها وليس أدل على ذلك من الأساطير اليونانية المكتوبة شعرا ، ( المعلقات العربية) ، الشعر العربي بعد الأسلام .. فتأصلت في النفوس وتجذرت وأخذت طابعا سحريا .
كانت هذه الحيازة التي نالتها القصيدة ، نالتها بشرط فني وشكلي واحد ، ولم تجسر على التعدد او التشكيل على مستوى الفكر العربي، ولكنها على الأقل ظلت محافظة على صيرورتها وديمومتها فلم تتعثر بأحلك الظروف ، وأخذت تجوس خلال معالم داكنة ومشرقة على الأغلب ، والقصيدة العراقية ـ كسواهاـ معروفة لدى الجميع حتى منتصف الثمانينات ولذلك فأن مايهمنا هنا ـ أنجازها بعد هذا التاريخ ولنسأل ـ هل اللغة التي كتب بها أسلافهم غيرها التي يكتبون بها ؟ هل الثقافة التي أقتنوها غيرها التي تسلح بها أسلافهم ؟ هل الأفكار والرؤى والمناخ والطموح غيره؟ لنستقصي أهم الحوافز التي أدت الى تشكيل القصيدة العراقية بأطارها المعروف مابعد جيل الحرب العالمية الثانية حتى الجيل السبعيني .
لا أحد ينكر ان الاستعمار كان آنذاك لايمثل ظاهرة سياسية وحسب تهم المشتغلين بالسياسة والأقتصاد ـ وحدهم ـ بل كان عنوانا للتخلف والأنحدار وضياع الهوية وتخريب الكيانات . والسبب الرئيس للتجويع .. أزاء هذه المشاهد ماذا بوسع النخبة ان تفعل ؟ ماعليها الا ان تدافع عن أفكارها واحلامها وحقوقها وخاصة هؤلاء الذين سجلوا ولاءهم لذواتهم على اقل تقدير ، وهكذا رأينا قصائد الاربعينيات والخمسينيات وحتى الستينيات تعج بالكثير من هذه الصور والمشاهد ، هذا على صعيد الفكر الموضوعي (العام) اما على مستوى الرؤية الفنية الذاتية ورؤاهم الجوانية المحايثة فلم تتضح تماما .وظلت غائبة ومائعة وعاصفة في لجة (العام) لكثير من الاسباب في طليعتها انهم لم يتخلصوا بعد من سلطة الغير وعقدة الاخر المسلح ، المضخم ،المستورد فظلت ذواتهم شاحبة مموهة ..لم يجرؤا ان ينفضوا غبار الآخر المصقع وبذلك ماعت كياناتهم ولم يجلوها الا بعد حين.
تحلل الافكار
وبعد أستتباب الامور أخذت الشعوب بالأنعتاق من ربقة المستعمر المعبأ بالسموم والهجينية آنئذ أخذت الافكار تتحلل بغفلة من سطوتها المعفنة لتنهض مهيضة بتصورات فضفاضة ولكنها لم تستطع بعد الإشاحة عن الماضي فما يزال يتفسخ في الامعاء، ليبذربلواقح فاعلة بذرته ، ولكنها مخصبة وأليفة فتنذر بجنين معفن ولكنه متسلط ، شائخ لكنه عضلاتي فيستضبع بعنوة .
هذه هي أهم الملامح التي كانت تلوح في الأفق الشعري في الفترة الممتدة قبل السبعينات والمؤثرة بنتائجها الى منتصف الثمانينات ، فلا يمكن والحالة هذه ان تولد قصيدة شامخة مستنفرة ومتوفزة ، قصيدة مؤسِسة ومهدمة هذا لايعني أن ننسف بل ان نستشرف ..فما عساه ان يلد اذن ؟ كم هائل غير مثمر أو صادم ، كم لايسعه إلاأن يتزوق لينتظم في رفوف من صاج او صندل ، ولهذا ظل يتسم بالغنائية والشرود والإفتعال المجاني، والضرورة، وأبتعد كثيرا عن الهم والذات والكشف والمباغتة والتجلي واللغة الفادحة والأشراق والتي بانت بوضوح في الشعر العراقي بعد منتصف الثمانينات لتتناغم مع الموجة اللونية للشعر العالمي لنصل بعد حين عميق الى عتيقهم البالي متلصصين عليهم من كوة معتمة ..
وبأدراك واعٍ ونظرة ثاقبة ورؤية نافذة أخذ هذا الجيل يتوحد مع مفرداته حتى هذا الخلط البائس الذي نلحظه في الكثير من القصائد / النصوص .. له ترددات محسوبة على مستوى الهم والنزعة والأتجاه ، لأنم الشاعر عندما يبصر الحقائق غير منتظمة بعقد أحلامه ، ونواياه المأمولة يظل يتخبط في جحيم طوعي يقيمه على أنقاض آماله المنخورة ،فيؤسس كما يريد ويشتهي خلايا متكورة بهياكل مقرورة، ان الاحلام لم تعد أحلاما وحسب ،فليس هناك أمل لردم فائضه الداهم، وليس ثمة مايعنيه لأنه لم يكن هناك مايستحق العناية ، بهذه الهواجس والتصورات ظل هذا الجيل يفصح عن نواياه بمنتهى الصراحة ، أنها احلام مشروعة ولاأحد له الحق في إجهاضها او ثلمها ولكن بالمقابل ان هذه النوايا لايمكن ان تتشكل وتقيم بلا أقنعة او حواجز ، بمعنى ان الأفكار تظل أفكارا مالم تنتظم بلغة ما ، فلا أحد يستطيع ان يتصور بدقة ماتضمر او أضمر، ماتنوي او أستبطن أنه يراك عندما تفصح وتفضح وبغير هذه الأشياء لايمكن تلمـس محيطك.
فاللغة محور الفكر وقاعدته الرصينة وأبسط أرهاصاتها وقواعدها قاعدتها المدعومة بالثقافة ، فالشاعر عليه ان يتحصن تجاه كل المؤثرات البيئية والنفسية وكما انه لايمكن ان نتصور هرما بلا مساند او صرحا بلا دعائم فلا يمكن تصور شاعر بلا شفرات ايحائية وعليه فلا يمكن أن نحمل هذه اللغة أوزارنا وأتعابنا بما لاطاقة لها به ،لأننا سنصل بها الى شواطيء ضحلة ، فاللغة أية لغة لها حدود في الممارسة والكتابة فلو أبتعدنا قليلا عن تخومها سنقع لامحالة تحت وطأة الوشاية بها والجناية عليها أننا نجني على اللغة لو حملناها مالاتحتمل ، وبدقة أبلغ ان الكلمة مالم تتصل بقرينتها بصفة متماثلة أو متباينة لايمكنها ان تؤلف معنى ما. حتى على أبعد مؤشرات التأويل ، فالصلة المبنية على المعنى المؤلف من مجموع كلمات تحقق أهدافها بعدة حوافز ، على المستوى النظري التفسيري إنها تؤشر بمدلولاتها الظاهرة التي لايمكن أجهاد الخيال في إستنباطها ، وعلى المستوى التأويلي انها تؤشربمدلولاتها البعيدة على النمط التخييلي الظني ، وبغير هذين البعدين لايمكن حمل الجملة الى معنى ما إلا ماتقتضيه الكلمة مفرغة من شحناتها الأتصالية ، وبهذه الحالة فلا مزية للشاعر في شحنه للموضوع بعيدا عن دوال الوعي المرسل والموهوم بالتلقائية .
إن الجملة الشعرية تحت أكثر الدعاوى تطرفآ يتوهم المعنى منها في أثنين فقط ، الظاهري المؤول بالظاهرـ والتأويلي المؤول بالتأويل ـ فالشعر المكتوب الآن يخضع لعملية من التأويل الستراتيجي العميق والمقصود بذلك إنه لايمكن خضوعه لقوانين اللغة أو البلاغة بل بما يتبادر في الذهن من إنبجاسات وفيوض تقتضيها القراءة الأولى للنص ، فالنص هنا لايمكن خضوعه لقراءات متعددة ، متأنية ومتأملة ، إذ أن هذه القراءات ستكشف عريـه فتدينه.
يمكننا القول ان التأويل السترتيجي هو إكتشاف منطقة مت من تالوعي كانت مجهولة في السابق لتضيء مساحة أخرى في الذهن ، أنها تكتشف الزائل وتحيله الى ثوابت راسخة ، بل أنها ترسخ المشطوب من ذاكرتنا لتعيدنا الى وعينا المستلب ، الضائع في معلرفنا المستهلكة ، أنها عملية أخرى للدخول الى النص ولكن بلا مديّات أو ضغائن وقبل ذلك كله علينا الأ نعادل بين مفاهيمنا القبلية وقراءتنا البعدية للنص ، بمعنى لايمكن ان نسلط معرفنا الأرثية على معارفنا النصية المقرؤة إنه لايمكن أن نضع النار على مقربة من الزيت ، وبالتالي لايمكن أن نسحب البساط من تحت أقدامنا ، سنهوي لامحالة في هوة التسطيح ، وندخل الى الماء العكر بوهم الأسـتحمام ، ولكي ندخل الى النص علينا أن ننزع ملابسنا اللغوية والنحوية التقليدية ، العُري هو السبيل الأمثل للأنقضاض على النص ، وبغيره سنقع تحت طائلة الترهل والتفسيرية ، النص المكتوب الآن هو تكفير عن آثامنا .
رقص الاشباح
التأويل السترتيجي نقاهتنا ولاسبيل إلاّ للأسترشاد به والأقتداء بهدايته ، انه العفوية التي ترغمنا على الرقص بين أشبح النص..لنعيد به ترتيب تراكماتنا الماضوية نقنن به لاوعينا ،النص الآن مؤهل تماما لتحفيزنا نحو ترشيق ذوتنا ، هذا مايمكن معاينته منذ الوهلة الأولى ولكن من جهة أخرى لايمكن ان نقف عند الحدود الوهمية التي تفصلنا عن المعنى المزئبق دون الولوج من طرف خفي الى هذه اللغة المشفرة الأيحائية ، فالنص إن لم يعط معاني متجاورة تولدها مجموع الجمل ، ربما تكون المعاني والدلالات مختلفة عن بعضها الآخر فهو يعطي بجملته إن لم تعط الكلمات معانيها المعتادة ،مشـهدآ عامآ ، هذا لايعني ان نجرد الكلمة من معجميتها ، إننا هنا أزاء منظور آخر ، فالكلمة في السياقات المعنوية للنص لم تعد تشكل مدلولها المعجمي في الشعر المتأخر ( الستيني ، السبعيني ) فكيف بنا ونحن على أعتاب نص آخر ( تفكيكي ) مفتوح وآيل للصعود.
إننا هنا ليس بصدد تغريب اللفظة ( مشاكسة المعجم) إننا بإزاء حالة اخرى ، حالة من التورط في اللغة إننا هنا في لغة داخل اللغة، في مناخ من التهويم والهيام ، وبتعبير آخران المعنى الذي يمكن أستباطه ، معنى نفسي غير خاضع للشرط الموضوعي الشائع في الشعر الغنائي ، بهذا فان النص متعدد المعنى والأنطباع بتعدد أمزجة المتلقي المبلّغ ، ولايمكنه فرض معنى واحد تقتضيه سياقات الألفاظ بأبعادها المعجمية والبلاغية ،أما على مستوى السياق المعنوي للنص فإن إستكناه دلالته الإيحائية بما يترتب على إشارة اللفظة من إضاءة تراثية او ماضوية عندئذ فإن ماضي النص يصبح قيمة مشـعة ألقآ يأخذ بمعاقد الأجفان ، يقول أدونيس في معرض تقديمه لقصائد يوسف الخال المختارة (فما يميز الخلاق عن غيره هو انه يعتبرقيم الماضي قيم إيحاء وإضاءة) بهذه الحالة فإن النص لايستقي موضوعه من رموز وأعلام مجردة عن تسمياتها المعهودة وحسب إنما يشحنها ويعبئها برؤيته عنهم ، بما يتوارد الى ذهنه من إنفلاتاتهم أو زيفهم ، تملقهم أو زلفاهم ، ولعل من الضروري القول بأن الشاعرـ كاتب النص ـ بقدر مايتحفظ على لغته ومعانيه من الأغتراب والأستلاب على القدر ذاته من التحفظ حيال الكثير من المواقف التي تقف حائلا دون إضفاء حالة من الأكتناز والفرادة الى ذاته ، بهذا فإنه يستطيع بلا أدنى مواربة ان يؤشر له مسارآ خارج لعنات الآخرين ولغوهم فلا شأن له إلاّ بما يعنيه أو يراوده ، حتى الحقائق والمسلمات التي آمن بها أسلافه لم تعد في حسبانه ، مطلقآ منزهآ ،عن الترهات والأباطيل ،على الشاعر ـ كاتب النص ـ العودة الى إنتمائه دون شوائب لكن بنزعاته وبما يجيش في مرجله ،دون الركون الى الرواسب والشظايا ، إذ ذاك يمكن أن يحقق مايسعى إليه . هذا ماحصل في الكتابات المتعددة لكثير من النصوص المنشورة بعد منتصف الثمانينات ، ولكي نضع رؤيتنا موضع التمثيل والمشاهدة لابد من الأحاطة ببعض النصوص المكتوبة في الفترة التي إستقطبت هذا الأنتباه وهذه المعاينة ، والنصوص على كثرتها لايمكن الأحاطة بجميعها وإنتقاء بعضها لايعني إهمال بعضها الآخر لأنه من العسير الألمام بها جميعاً .